
تُرجمت هذه المقالة بدعم من مبادرة «ترجم»، إحدى مبادرات هيئة الأدب والنشر والترجمة
الآراء والأفكار الواردة في المقال تمثل وجهة نظر المؤلف فقط
لتحميل المقالة : إساءات فهم كارل بوبر
لو توجَّهت إلى الباحثين في الفكر الفلسفي -على الأقل المنتمين منهم إلى العالم الناطق باللسان الإنجليزي- بسؤالٍ لماذا يشتغل العلم، لأشاروا على الدوام تقريبًا إلى الفيلسوف كارل بوبر من أجل الإثبات والتبرير؛ لأن العلم ليس يزعمُ تقديمَ إجابة نهائيةٍ وقطعية عن أي سؤال كان، بل يحصرُ نفسه في محاولة التفنيد[1] فحسب، فهو، وفقًا لزعم أشياع بوبر، آلةٌ عنيدة لهدم الأكاذيب وتقويضها.
قضى كارل بوبر فترة شبابه في مدينة فيينا وسط النخبة الليبرالية، وكان والده المحامي محبًّا للكتب شغوفًا بها وصديقًا حميمًا لروزا غراف شقيقة سيغموند فرويد. وقد تنوع أول ما مارسَهُ كارل بوبر بين عزف الموسيقى وصناعة الخزائن الخشبية[2]، وفلسفة التربية، وفي سنة 1928 نال شهادة الدكتوراة من جامعة فيينا في تخصص علم النفس[3]، ولأنه كان يُدرك أن حصوله على وظيفة أكاديمية في الخارج سيتيح له الهروب من النمسا التي ازدادت معاداتُها للسامية (أجداد بوبر جميعهم من اليهود، حتى وإن كان هو نفسُه قد اختار التعميد على المذهب اللوثري)، عجَّلَ بتأليف كتابه الأول، الذي أصدره تحت عنوان «منطق الكشف العلمي»[4] (1935)، وفيه عرض منهجَه في التَّكذيب، ويتمثل النَّهج أو السيرورة العلمية، كما يكتب بوبر، في تخمين الفرضية ثم محاولة تكذيبها، إذ إن ما يتعين القيام به هو تهيئَةُ التجربةِ من أجل محاولة إثبات خطأ الفرضية، فإنْ هي لم تستطع الصمود وتأكّدَ عدم صحتها، وجبَ التّخلّي عنها، وهنا على وجه التَّحديد، كما يقول بوبر، يكمُنُ أكبر تمييزٍ بين العلم والعلم الزائف، هذا الأخير الذي يحاول الاحتماء من التّفنيد والدّحض بجعله النظرية أكثر مرونة، بيد أن الحكم النافذ في مجال العلم هو إمّا كل شيء أو لا شيء؛ إما أن تعمل النظرية وتؤدي وظيفتها أو أن تموت وتُقبر.
يتوجه بوبر إلى العلماء بتحذير مؤدّاهُ أن الاختبارات التجريبية إن كان في إمكانها تقريبهم من الحقيقة بفضل التّعزيز[5]، فإن ذلك ليس بكافٍ كي يكون في وسعهم الإعلان عن كونهم على صواب، بل من واجبهم ألا يُقْدِمُوا على ذلك، لأن ما يعنيه منطق الاستقراء[6] هو أنك لن تبلغ أبدًا مبلغَ جمعِ ما لانهاية له من الأدلة الضرورية كي تكون على أتم اليقين من صحة الفرضيات في جميع الحالات الممكنة، وإذن الأفضلُ سيكون هو النظرُ إلى المعارف العلمية في مجموعها على أنها ليست بالصحيحة إلا بقدر ما هو تفنيدٌ مؤَجَّلٌ لها وأنّ دحضَها لم يحِنْ أوانُه بعدُ، وإن شِئْتَ قُلْتَ هي صحيحة صحة مؤقتة.
حصَل بوبر وهو مسلّحٌ بكتابه (المذكور آنفا) على منصب جامعي في نيوزيلندا، ومنها راقب من بعيد سقوط النمسا في قبضة النازية، فكان شرُوعه في العمل على كتاب يكون ذا طابع سياسي أكثر، وقد صدر بعنوان «المجتمع المفتوح وأعداؤه»[7] (1945)، وبعد الحرب بمدة قصيرة، انتقل إلى المملكة المتحدة ليستقر بها لبقية عمره.
ورغم البساطة الجذّابةِ التي ميّزَتِ معيار التكذيب، فإن الفلاسفة سرعان ما تخلّوا عنه، مبرزين أن الأمر يرتبط بكيفية لا يمكن التمسك بها والدفاع عنها عند النظر إلى العلم، مُنبّهين إلى أن أي إعداد تجريبي واقعي يبقى من باب المستحيل أن نعزل فيه عُنصرًا افتراضيًا واحدًا من أجل تفنيدِه ودحضِه، ومع ذلك ظلّت النزعة البوبرية شديدة الانتشار، قوية الشيوع في صفوف العلماء أنفسهم، على الرغم مما أمكنها أن تنطوي عليه من أضرارٍ جانبية، ما يدفعنا إلى التساؤل عن الأسباب التي تقف وراء ذلك؟
إن جماعةً من علماء البيولوجيا هي أول من منح لكارل بوبر جمهورًا وصيتًا علميًا، علماءٍ تحقّق لقاؤهم إبان الثلاثينات والأربعينات من القرن العشرين بنادي البيولوجيا النظرية[8] في جامعة أكسفورد، وبحفلاتٍ منزلية في ساري ثم في لندن، وقد زارهم بوبر قبل الحرب العالمية الثانية وبعدها، في فترةٍ كانوا يواجهون فيها نظرية التطور ويناضلون من أجل إقامة روابط وصلاتٍ بين مختلف التخصصات البيولوجية؛ حيثُ إن الموقف من البيولوجيا التطورية إبان الفترة السابقة على الحرب ما كان ليخرج عن أحد أمرين؛ إما أنها ذات تعقيدٍ مثيرٍ للإعجاب والشّغف أو أنها ذات غموضٍ مستعصٍ ومُربك، فتصارعت أبرع نظريات التطور الماندلي (نسبة إلى غريغور ماندل[9]) الذي يفهم توريت الصفات الخفية عشوائيًا على غرار ما يحدُث عند رمي قطعة نقدية، تصارعت تلك النظريات، متوسّلةً في ذلك توصيفاتٍ إحصائيةٍ غامضة، لأجل تفسير تطور الصفات الوراثية وانتقالها المستمر بالتدريج عبر الفئات السكانية.
في هذا الوقت كان جوزيف هنري وودجر، رائد النادي ونجمه، يأمل في إيجاد كيفية محكمة فلسفيًا لإيضاح وبيان مفهوم «العضوية» (organicism) بوصفه مفهومًا بيولوجيًا اشتهر بغموضه والتباسه، وصرامةُ كارل بوبر ربّما أمكنَها المساعدة في تحقيق المُراد.

إنه لَأمرٌ صادم أن يكون أكثر المعجبين حماسةً بكارل بوبر منحدرين من علوم الحياة والأرض: الأسترالي جون إكليس عالم الفسيولوجيا العصبية، والنيوزيلندي كلارونس بالمر عالم الأرصاد الجوية، والأسترالي جيفري ليبر عالم التربة، وحتى النمساوي البريطاني هيرمان بوندي، الذي بحث في الجانب التأملي لعلم الكونيات، وبعبارة أخرى، فإن هؤلاء العلماء الذين كان من اليسير جدًا تعريضُ عملهم العلمي للخطر عبر محاولة التفنيد في المختبر، كما يقضي بذلك منهج كارل بوبر، هم من لاذوا ببوبر بُغية تحصيل تبريرٍ وتسويغٍ لعملهم، وهو أمر أقل ما يُقال عنه أنه مدعاة للاستغراب.
الراجح أنهم كانوا يأملون في إكساب عملهم ضربًا من الثقل الإبستيمولوجي، وبغية إحاطة أشمل بهذا السّر، يمكننا الإشارة إلى «حسد الفيزياء»[10] الذي كان يُنسب أحيانًا إلى علماء نفس في القرن العشرين؛ بمعنى ما كانوا يكابدونه أحيانًا من غياب نسبي للاحترام في الدوائر العلمية والعامة على السواء، فظهر لهم بوبر بمثابة المُخَلِّص من هذا الشر المخصوص.
ومن بين العلماء الفلاسفة الذين كان لهم شغفٌ بفلسفة نادي البيولوجيا النظرية وتحمّسوا لها، نجد شابًا اسمه بيتر مدور، الذي بمجرد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، سارع إلى الانخراط في مختبر لزراعة الأنسجة، حيث كانت انطلاقة مساره العلمي الذي انتهى به مُتوّجًا بجائزة نوبل في البيولوجيا، ولم يدّخر مدور جهدًا، سواء في كتبه الموجَّهة لجمهور القراء الواسع أو في محاضرات جون ريت التي ألقاها بهيئة الإذاعة البريطانية BBC سنة 1959، لم يَأْلُ جهدًا في أن ينْسب الفضل كل الفضلِ في نجاح العلم إلى كارل بوبر، بحيث صار هو أبرز حاملي لواء النزعة البوبرية. (ريتشارد دوكينز وصف بدوره مدور بأنه الناطق الرسمي باسم «رجل العلم»، كما تحدث بصورةٍ إيجابية عن «قابلية التكذيب»). وفي محاضراته الإذاعية فصّل مدور القول في تقديم وعرض «فلسفة الحس السليم» لكارل بوبر، حيث شرح بمنتهى الوضوح كيف أن نفس الفرضيات حول مستقبل البشرية الوراثي يمكن اختبارها بشكل تجريبي وفقًا للموجهات والمبادئ التي وضعها كارل بوبر، غير أن الاعتراف والتقدير الأكثر أهمية الذي حظي به بوبر كان ذاك الذي منحَهُ إيّاه مدور سنة 1976؛ أعني زمالة نادرة بين غير العلماء بالجمعية الملكية للعلوم في لندن.
حدث ذلك بينما كان ثلاثة فلاسفة يسحبون البساط من تحت أقدام أنصار كارل بوبر، مدافعين عن كون فشل التجربة في إثبات فرضية من الفرضيات، ربما يكون عائدًا إلى الإعداد النظري والمادي، كما لا يمكن الاعتداد بتفنيدٍ واحدٍ ضد نظرية من النظريات، ما دام في إمكاننا وضع فرضية مساعدة بحسن نية لأجل حمايتها؛ من قبيل أن فئران المختبر لم تتم تربيتها داخليًا بدرجة تكفي لإنتاج التماسك الوراثي، أو أن التفاعل الكيمائي قد لا يحدث إلا في وجود مُحفِّزٍ بعينه، وفوق هذا وذاك، يلزمُنا في أحايين كثيرة، حماية بعض النظريات من التكذيب لمجرد القدرة على التفاهم والاستمرار في التقدم. كما أننا بالإجمال علينا ألا نستنتج أننا قد فنّدنا قوانينَ الفيزياء الراسخة، بل الأحرى بنا أن نستنتج أن تجربتنا هي التي يعتريها النقص، لكن على الرغم من ذلك لم يضطرب المدافعون عن التصور البوبري، فما الذي أدركوه فيه وجعلهم أكثر تمسُّكا به؟
دافع المؤرّخُ نيل كالفير سنة 2013 عن أطروحة مؤدّاها أن أعضاء الجمعية الملكية لم يكونوا متأثرين بقواعد كارل بوبر الإبيستيمولوجية في البحث العلمي، بقدر ما كان تأثّرُهم بطلاوة ونفاذ أسلوبه الفلسفي؛ فقد عاشوا طيلة الستينات من القرن العشرين بنقاش «الثقافتين» الذي قدّمهم باعتبارهم مجرّد تقنيّين معتدين بأنفسهم، إن هم قُورِنُوا بالمبدعين المهمّين للثقافة الراقية؛ فكانت الفلسفة بمثابة سلاحٍ مثالي يمكنهم من الردّ، ما دامت تُبرزُ الصلات والروابط القائمة بين الفنون، لا سيما ما سرده بوبر حول ما يأتي قبل التكذيب في البحث العلمي، الذي مثّل دفاعًا ممتازًا عن الخواص «الثقافية» للعلم، فهو يصف هذه المرحلة بأنها «تخمينٌ»[11] وفعلٌ للمخيلة، وقد استفاد مدور وآخرون من هذا الجانب الإبداعي للعلم من أجل الحفاظ على المجد الثقافي لميدانهم. وإذن فكارل بوبر كما يحضر لديهم ويتمثلونه، ليس هو بوبر صاحب مبدأ التكذيب، بل بوبر آخر قُدَّتْ صورتُه بما يتناسب مع منظور ما كانوا يرغبونه.
رغم الأهمية التي انطوى عليها النقاش حول «الثقافتين» بالنسبة لمن شارك فيه، فإنه لم يكن ذا تأثير على الصعيد المؤسساتي؛ ففي أواخر الخمسينات وبداية الستينات من القرن الماضي، حين صُدور الكتاب العُمدة لكارل بوبر «منطق الكشف العلمي» باللغة الإنجليزية، لم تأتِ رياح التاريخ بما تشتهيه سُفن الجمعية الملكية؛ بحيث صار العالِمُ يُمَثِّلُ في ذهن الجمهور العام وجهًا خطيرًا، وشبحًا مخيفًا مسؤولاً عن صناعة القنبلة الذرية، وقد مثّلت شخصية الدكتور سترينجلوف –التي أداها أداءً لا ينسى الممثل بيتر سيلرز في فلم حمل اسم الشخصية من إخراج ستانلي كوبريك سنة 1964- تجسيدًا نوعيًا لهذه الصورة التي صارت لرجل العلم؛ فشخصية الدكتور سترينجلوف تماشتْ مع مُثل فلسفة كارل بوبر؛ فهذا عالم، ونازي سابقًا، يعملُ في مركزٍ في «العالم الحر». جاءت شخصيتُه عاكسةً لقصص واقعية أبطالُها مجرمو الحرب النازيون الذين نُقلوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الإسهام في الجهود التي تطلَّبتها الحرب الباردة، عبر عملية «مشبك الورق»، أحد مشاريع وكالة الاستخبارات التي تم كشفها سنة 1951 من طرف صحيفة «بوستن غلوب».
في ظل سياقٍ بهذه الملامح كان تواضع العلم واقتصاره على ما هو معرفي وفق التصور البوبري جذابًا فعلاً، لأن العلماء الحقيقيين داخل عالم بوبر، ينبذُون كل سياسية ويتخلون عن التمسك بأي حقيقة مطلقة، فهم لا يبحثون عن معرفة الذّرة ولا عن كسبِ الحُروب، بل إن غاية ما يرُومُون بلُوغَه بكامل البساطة هو الدحض والتفنيد، وكما قال مدور في «أمل التقدم» (1972): «إن لفظ العالم الشرّير لا ينبغي أخذُه على جهة الحقيقة … فبالمقابل هناك أشرار كثيرون في صفوف الفلاسفة والكهنة ورجال السياسة».
مثَّل مبدأ التكذيب أيضًا وصفة لإعلان التواضع الشخصي، فهذا جون هيليويل الذي ابتكر منهجًا جديدًا لجعل البروتينات والفيروسات مرئية، يرفض في حوارٍ أجراه معه سنة 2017 «مشروع التاريخ الشفهي للعلوم البريطانية» أنْ يكون أحدَثَ ثورةً في النموذج الإرشادي المعرفي («بارادايم» وفقا لتوماس كون المعاصر لكارل بوبر)، مفضّلاً استخدام منهج التكذيب المتواضع لوصف عمله.
بيد أن تواضع شخصٍ ما يمكن أن يكون إنكارًا للمسؤولية من شخصٍ آخر، لذلك فإن الجانب المظلم لسردية «بوبر يعارض الدكتور سترينجلوف»، مؤداها أن مبدأ التكذيب يؤمّن حصانةً وعدم مساءلة أخلاقية لمن ينخرطون فيه ويلتزمون به؛ لأن رجل العلم لا يمكن أن يُتَّهمَ أبدًا بدعم ومساندة قضية خاطئة ما دام عمله ليس متعلقًا بالإثبات، وبوبر نفسُه يعلن أن العلم هو عملٌ نظريٌ بالأساس. إلا أن العلماء السذج هم مَن عَمِلوا طيلة فترة الحرب العالمية الثانية دون أن يُدركوا ما لمصدر تمويل أبحاثه من أهمية، ولا أهمية ما يترَتَّب عنها، ولنضرب لذلك مثلاً بحالة مِدور، فقد كان يعرفُ تمام المعرفة أن مجال بحثه في المناعة ينحدر بكيفيةٍ مباشرةٍ من تجارب زرع الجلد وترقيعه على المصابين من ضحايا الحرب العالمية الثانية، كما كان على أتمِّ وعيٍ بالعدَد الكبير من الجثث التي تم استخدامها في تجاربه (بما في ذلك جثت المجرمين ممّن تم إعدامهم في فرنسا)، وهو ليس غير أخلاقي بالضرورة، إلا أنه أبعدُ ما يكون عن أن يكون نظريًا وحسب.
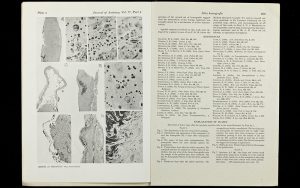
جرى توظيفُ حُسن التخلص البوبري في أكثر العلوم إثارةً للجدل في القرن العشرين، أعني تحسين النسل أو النسالة eugenics، بحيث لم يتورع بيتر مدور في استثمار وجود العلم بمعزلٍ عن الأخلاق وعدم خضوعه للمساءلة الأخلاقية، دفاعًا عن النسالة أو علم تحسين النسل، باعتباره الموضوع الذي شكّل أساس محاضراته في إطار محاضرات جون ريت بهيئة الإذاعة البريطانية وغيرها كثير من المحاضرات التي أعقبتها، وفي حجته البارعة عمدَ أولاً إلى التمييز في علم تحسين النسل بين نوعين، علم تحسين النسل «الإيجابي» ويعني ابتكار العرق الأكمل، وقد اعتبره علمًا سيئًا لأنه (أ) علمٌ نازيٌ و(ب) لأنه موضوعٌ علميٌ لا يقبل التكذيب، وعليه فهو غير بوبري لهذين الاعتبارين، ما مَهّد الطريق أمام مدور لتقديم دعمه لـ«علم تحسين النسل السلبي»، الذي يعني الوقاية من الحمل ومنعه عن سابق رويّة وتدبُّر بالنسبة للأشخاص الحاملين لبعض الأمراض الوراثية، والأمر يرتبط، من وجهة نظره، بمسألةٍ علميةٍ بحتة (بمعنى بوبري)، لا تمسّ الأسئلة الأخلاقية، لكننا نجد أنفسنا في الواقع أمام حجَّةٍ فاسدة بل ومشينة.
وبالنظر إلى ضجر البوبريين من إمعان البحث في معاني الكلمات عوضًا عن المقصود منها، تخلّص مدور مما يمكن أن يثيرهُ ضِمنيًا مصطلح «صلاحية» (التطهيري) من حكم على من هو «صالح» أو «غير صالح» لأن يكون جزءًا من المجتمع. فالمصطلح في نظره ليس إلا علامة ملائمة لفكرة شديدة الوضوح في أذهان علماء البيولوجيا التطورية، وبالتالي ليس على الناس العاديين شَغْلُ أنفسِهم بتداعياتها وآثارها، ما دام العلماء قد حصّلُوا فهمًا تامًا لها؛ لأن العلم يكتفي من جهته بتقديم وعرض الوقائع أمّا اتخاذ القرار فمسألةٌ تعود إلى الوالد المحتمل. وإلى هنا يبدو أن الأمر، عند مستوى من المستويات، أمرٌ محمودٌ ومن غير مساوئ، أضف إلى ذلك أن بيتر مدور لم يكن بأي حالٍ من الأحوال شخصًا سيئًا، بيْد أن ما يظل من باب قصر النظر على الصعيد الفكري هو أن يتم بتر صلة العلم بالأخلاق بهذه الكيفية. فافتراض في هذا السياق حالةً يتخذ فيها والدٌ محتملٌ اختيارًا حرًا تمامًا قد أضفى بذلك على الوقائع العلمية نزاهةً لا تبرير لها؛ فالاقتصاد والسياسة قد يمارسان إكراههما عليه، ويمكن أخذ مثالٍ آخر أكثر تطرفًا، يجعل هذه القضية أوضح؛ هَبْ أنَّ عالمًا شرح التكنولوجيا النووية لطاغيةٍ يهْوَى شنَّ الحروب، تاركًا له مسألة الاختيار الأخلاقي لاستخدامها من عدمه، عندها لن نقول عن العالِم إنه تصرّف بمسؤولية.
أثناء إعداده لمحاضراته حول «مستقبل الإنسان» تنبَّه مدور إلى أن فهمًا أفضلَ سيتحقق لـ«الصلاحية البيولوجية» إذا تم النظر إليها باعتبارها ظاهرةً اقتصاديةً: «فهي تمثل في واقع الأمر نظام تقويمٍ للكائنات العضوية بعملة النّسل؛ أي على ضوء محصلة الأداء الإنجابي».
إن إقامة علاقة من هذا القبيل بين اليد الخفية للطبيعة وقرارات السّوق غير المنحازة، تمثل نهجًا مثيرًا في قراءة كارل بوبر، وبالفعل فإن أحد أكبر معجبيه كان من خارج دائرة الجماعة العلمية، منتميًا إلى أوساط الاقتصاد، إذ كان بوبر قريبًا في كلية الاقتصاد من منظّر الليبرالية الجديدة فريدريك هايك[12]، كما درّس من سيصير فيما بعد الملياردير جورج سروس الذي أطلق على مؤسسته اسم المجتمع المفتوح (كانت تسمى سابقًا «معهد المجتمع المفتوح»)، استلهامًا لأكثر كتب كارل بوبر شهرة، كما أسّس كارل بوبر مع هايك وآخرين «جمعية مون بيلران»[13] التي تعمل على تشجيع اقتصاد السوق والخصخصة في جميع أنحاء العالم.
إن تعيين كارل بوبر في الجمعية الملكية مثَّلَ علامةً بارزةً على نهاية تيارٍ قويٍ للقيادة الاشتراكية داخل العلوم البريطانية، ابتدأ في الثلاثينات من القرن العشرين مع مجموعة مُكَونة من باحثين موهوبين ومنفتحين على الجمهور (جون ديزموند برنال، جون بوردون ساندرسون هالدين، وآخرين)، أطلق عليها المؤرّخ جاري ويرسكي سنة 1978 اسم «الكلية المرئية»، وقد التقى كارل بوبر بالعديد منهم عند زياراته لجمعية «نادي البيولوجيا النظرية» قبل الحرب العالمية الثانية. وبينما كانوا يشحذون علومهم المعقدة ضد فلسفة كارل بوبر، شحذ بوبر ميوله المضادة للماركسية، في مواجهة نظرتهم الاشتراكية للعلم، بل ولربما حتى ضد أشخاصهم، وما قام به كارل بوبر في كتابه «المجتمع المفتوح وأعداؤه» هو أنّه أخذ عملية تسْييس العلم من قبل البيولوجيين وألصقها بمناهضة الفاشية؛ بمعنى أن الفلسفة والعلم مرتبطان، لكن ليس وفقًا للكيفية التي يزعمها الاشتراكيون، بل إن العلم بالأحرى نموذجٌ خاصٌ للفضائل والمزايا الليبرالية التي لا يمكن أن تُزْرَع ولا أن تترعرع إلا في غياب الاستبداد.
لقد أفضى التزام علماء «الكلية المرئية» وانخراطهم في بناء الأمة إلى مشاركتهم في العديد من مجالات الحياة العمومية والحكومية والتربوية، ما جعل أصحاب النزعة البوبرية يكرهونهم؛ ففي كتابه «الطريق إلى العبودية» (1944) حذّر هايك مِمّن سماهم بـ«الشموليين الموجودين بيننا»، الذين يتآمرون لبناء نظام ماركسي؛ لذلك يتعين عليهم التزام حدودهم والقبول بأن أعمالهم في المختبر ليس لها أدنى علاقة مع المسائل والمشكلات الاجتماعية، غير أن إعمال هايك لتعليق الحكم الرشيد ووضعه بين قوسين لم يكن سديدًا في العلم كما في الاقتصاد؛ ذلك أن أكبر خرافة لليبرالية الجديدة هي إيمانها بأنها تمثّل منظورًا محايدًا على صعيد السياسة –الالتزام المطلق بعدم التدخّل- بينما يتعين أن يستمر دعمها في الواقع بحملة دعائية عدائية تؤيّد الأعمال التجارية وإلغاء العمل المنظم، ورغم أن النشاط الاجتماعي لسورس قد حقَّق الكثير من الخير في العالم، إلا أن تمويلَهُ قد تحقَّق اعتمادًا على نشاطٍ اقتصاديٍ يتوقف نجاحه على القمع المُمنهج للنقاش وللكائنات الإنسانية، لذلك فإن تأمين غطاءٍ فلسفيٍ لهذا النوع من الليبرالية الجديدة، عبر مماثلتها بالعلم وفقًا لتصور كارل بوبر، لن يضرّ في شيء.
إن التفكير والكتابة حول بوبر تجعل المرء على وعيٍ شديدٍ بنزعة معاداة السامية؛ فهو نفسه قد فرّ من النازية في النمسا خلال الثلاثينات من القرن العشرين واليوم نجد سورس ضحية إهانات معادية للسامية، كان يمكن النظر إليها على أنها مجرد سخافات لولا ما يقدمه التاريخ من كونها تهديدًا حقيقيًا ومستمرًا بالعنف الذي انغرست جذورها فيه، لذلك سيكون من الأفضل التذكير بالأسباب الذاتية في مسيرته والتي كانت وراء تشجيع كارل بوبر للمجتمع المفتوح والدفاع عنه، ومحاولته تخليص العِلم من بين براثن الأخطاء التي ارتكبها العلماء النازيون في حقه، بيد أن الاستبعاد والإقصاء الماكر للعلم الفاشي والاشتراكي بوصفه خصمًا للنزعة البوبرية، عن قصدٍ أحيانًا و أحيانًا أخرى دونه، يمثّل نهجًا من العسير جدًا أن يكون محطّ تعاطف.
إن العلم يلحقه تغييرٌ عميقٌ حين النظر إليه بوصفه مماثلاً للسوق المفتوحة، وفكرة أن النظريات العلمية تتصارع فيما بينها في إطار منافسةٍ مفتوحةٍ، هي فكرةٌ تُسقط من اعتبارها كون طموحات البحث والاختيارات التي ترتبط بالتمويل، إنّما تضعُها سياسات الشركات الكبيرة منها والصغيرة، لذلك فإن ما أُحرِز من تقدمٍ في صناعة الأدوية الخاصة بعلاج الأمراض التي تنتشر وسط الأغنياء، ليس نابعًا من فراغٍ ولا هو وليد صدفةٍ إذا ما قُورِن بما أُنجز في صناعة الأدوية المُعالِجة للأمراض التي تصيب الفقراء، فضلاً عن أن النجاح المهني في المجال العلمي هو الذي يُحدِّد بدوره البرامج المستقبلية للبحث العلمي، لا سيما حين يصير الشخص رائدًا في مجاله، والذي يتأثَّرُ تأثُّرًا عميقًا بالنوع الاجتماعي والطبقة الاجتماعية ثم بمدى توافر الكفاءة.
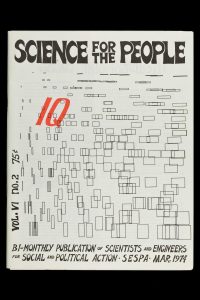
حتى أن بعضًا من العلماء ممن تعطّل ضميرهم، استخدموا الإطار البوبري ليصيروا، على وجه التحديد، هم عين «العلماء الأشرار» الذين سبق لبيتر مدور إنكارُ وجودِهم، وفي هذا السياق تصف المُؤرّخة نعومي أوريسكس والمؤرّخ إريك كونواي في كتابهما الصادر سنة 2010 بعنوان «تجار الشك» عملية اختيار علماءٍ في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة في أواخر القرن العشرين كي يشكِّلُوا جماعات ضغطٍ تعمل لصالح شركات التبغ، عبر التشكيك في الأبحاث التي اكتشفت وجود علاقة ارتباط مؤكّدة بين التدخين والإصابة بالسرطان؛ فمثل هذا الارتباط ليس في الإمكان إثباته، من المنظور البوبري، وهي مساحة الشك التي لم يتردد دافعو أجور العلماء في استغلالها دون رحمة، كما أن عددًا من هؤلاء العلماء اشتغلوا هم أنفسهم لصالح جماعات الضغط المدافعة عن استخدام الوقود الأحفوري، بُغيةَ التّشكيك في علم التّغيُّر المناخي الذي كان التدخل البشري في الطبيعة سببًا فيه، وللتأكد من ذلك فإن محرك البحث على شبكة الإنترنت لا يستغرق كثيرَ وقْتٍ في العثور على أمثلة للبوبرية التي يستخدمُها هؤلاء ومن على شاكلتهم من المنكرين للتغيّر المناخي؛ ففي مقطع فيديو على اليوتيوب يعود إلى سنة 2019 استحضر «حلف الطاقة النظيفة» Clear Energy Alliance (الذي تضعه مدونة DeSmog Blog وهي من بين المنظمات التي تحصل على التمويل من المصالح النفطية) الفيلسوف الأسطوري كارل بوبر، ودعا إلى الرجوع إليه، والدعوة المركزية للمجموعة هي: «داخل نظام المعرفة، لا يمكن لنظرية من النظريات أن تكون صحيحة، إلا إذا كانت هناك طريقةٌ لإثبات خطئها، غير أن الكثير من علماء التغير المناخي ووسائل الإعلام ونشطاء البيئة، يتجاهلون هذا الأمر الذي يتنزّلُ منزلة حجر الزاوية من العلم»، وفي الوقت نفسه، نجد أساتذةً ينتسبون إلى جامعات مرموقة، يعدّون أوراقًا علميةً لصالح معهد كاتو التحرُّري ذي التوجه الليبرالي الجديد المشكّك، مؤكدين على أن «الإبيستيمولوجيا التطورية لكارل بوبر تدرس […] ماهية العلم، غير أن مسلك علم المناخ اليوم يظل أبعد ما يكون عنها». وينحدر هؤلاء المؤلفون عمومًا من ميدان الاقتصاد والسياسة أكثر مما هم منتمون إلى العلم، وبالتالي فهم لا ينزعجون من نقد العلماء ولا يحفلون به، مما يجعل سردية كارل بوبر حول العلم التي صارت مثار شك وعفا عليها الزمن تناسبهم تمامًا.
إن تمسُّك فردريك هايك وغيره بالدليل القاطع على المكر البوبري، لا ينفي وجود أسباب أخرى توجّهُها نوايا حسنة للالتزام بالنموذج البسيط للعلم الشّكي؛ خاصة وأنه يتوافق مع سردية الاستحقاق والجدارة؛ أعني ذلك التصور الذي يرى أن العلم، أكثر من أي مجال آخر، هو الأنسب للطبقة العاملة والطبقة الوسطى لأجل تحقيق الارتقاء الاجتماعي، ولا ريب أن إدراك جماليات الاكتمال أو فهم رياضيات الإثبات يلزمهما نوعٌ بعينه من التربية والتعليم، إلا أن أي طفل في مقدروه فَتْحُ ثغراتٍ في شيءٍ ما، وإذا كان هذا هو العلم، فهو مفتوحٌ مُشرعٌ أمام الجميع، بغضّ النظر عن انتمائهم الطبقي، وذاك هو الاستحقاق والجدارة الذي مثّل الحلم الذي حرّك رجال التربية في سنوات الخمسينات من القرن الفائت؛ أي إنّ بريطانيا ستكون وفق هذا التوصيف ذات حديثة ثقافيًا ومتقدمة علميًا، فكلاهما (الثقافي والعلمي) يكمل بعضهما بعضًا.
غير أن هذا الحلم انقلب وكانت له نتائجٌ عكسيةٌ؛ فالتصور الذي جعل مدار العلم مبدأ التكذيب كانت له انعكاساتٌ سلبيةٌ تجاوزت حدود العلم لتمسّ رفاهية الإنسان وعيشه الكريم؛ لأنه جعل من عدم الثقة أمرًا طبيعيًا ونصّبَهُ شرطًا لبناء المعرفة، هكذا نجد المشككين في التغيُّر المناخي الناجم عن تدخل الإنسان في الطبيعة، يطالبون بتنبؤاتٍ دقيقةٍ هي أقرب إلى ضربٍ من المستحيل، لكنهم يحتفظون في المقابل، بمعطىً واحدٍ شاذٍ يدحضون به البناء المشترك للبحث العلمي برُمّته، وذلك كما أن مَن يعارضون التطعيم يرفضون كل حجة ممكنة للأمن والسلامة حتّى يتمكّنوا من تغذية نشاطهم الهدام، وبهذا المعنى تكون الفلسفة البوبرية أمام أسئلةٍ كثيرةٍ يلزمها الإجابة عنها.
شارلوت سلاي أستاذة العلوم الإنسانية وأستاذة فخرية في التاريخ بجامعة كنت بالمملكة المتحدة، من كتبها الأدب والعلوم (2010) Literature and Science (2010) ، أوراق حديقة الحيوانات (2016) The Paper Zoo. ، الإنسان (2020) Human ، وقد ألفتها بمعية أماندا ريس.
[1] على الرغم مما في الدائرة الدلالية لفعل «كذّب» من معانٍ تَدِقُّ تبعًا لما إذا كان الفعل لازمًا أو متعديًا، سواء بنفسه أو بحرف واحد، فالمعنى الذي يظل أقرب إلى المقصود في سياق إبيستيمولوجيا بوبر، هو معنى الإبطال والنقض، وعلى هذا سار من نقلوا وقرّبوا فكر الرّجل إلى الأفق التداولي للقارئ العربي، فتجدهم في الغالب يستعملون «التكذيبfalsification » و«التفنيدréfutation » على جهة الترادف، لأن فعل «فنّد» بتضعيف العين، يفيد من بين ما يُفيد «بيان خطأ القول وردُّه على صاحبه»، وهو ما يمكن أن نلمسهُ على سبيل المثال، في جنوح الدكتور ماهر عبد القادر في ترجمته عن اللغة الإنجليزية للكتاب العُمدة لكارل بوبر، الذي جاءت بعنوان «منطق الكشف العلمي» الصادرة عن دار النهضة للطباعة والنشر، بيروت (1986)، إلى استعمال «التكذيب»؛ حيث جعل «قابلية التكذيب» مقابلاً لـ«falsifiability»، بينما فضّل الدكتور محمد البغدادي استعمال لفظ «التفنيد» و«القابلية للتفنيد»، في ترجمته عن اللغة الألمانية، للطبعةَ العاشرة لنفس الكتاب، وهي الترجمة التي صدرت عن المنظمة العربية للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، بيروت 2006، والتي وضع لها عنوان «منطق البحث العلمي». ومع ذلك يبقى الغالب في مُتون مقرّبي فكر بوبر من القراء العرب، هو الترادفُ بين اللفظين، مع غلبة توظيف «التكذيب» على مستوى ترويج المصطلحات الأساسية لابيستيمولوجيا بوبر، غير أن ذلك لا يمسُّ في شيءٍ بالجوهر، لأن واحدًا من كتب بوبر جاء بعنوان «تخمينات وتفنيدات» ويمكن إبدال اللفظ الأخير بـ«تكذيبات» دون أن يختل المعنى، أضف إلى ذلك أن الأساس هو كون محكّ المنزلة العلمية لنظرية من النظريات هو «قابليتها للتكذيب» Falsifiability أو قابيلتها للتفنيد Refutability، أو قابليتها للاختبار Testability، وهو ما يتوافق مع منظور بوبر نفسه في تعاطيه مع الدلالات وتسفيهه لتعامل أصحاب النزوع الماهوي معها، الذين يجعلون من النَّبش فيها فعلاً يمارس لأجل ذاته فيما يشبه العرض القهري لا التفكير السليم. [جميع الهوامش من وضع المترجم].
[2] غالبًا ما يكون تشكل البُنيانٍ الفكري، حصيلةً لتلاقح وتلاقي العديد من الروافد التي لا يمكن فصلُها عن ما هو ذاتي أو بيوغرافي، حتى في تلك الحقول التي يخالُهَا المرءُ أكثر موضوعيةً ومجافاةً للتجارب الذاتية، وهذا ما يصدُق على بوبر، فما مارسه من مهنٍ أثَّر في تكوين فلسفته؛ فهو يقرّ مثلا بأن «الموسيقى الأوربية المتعددة النَّغَم، كانت ملهمةً لبعض اتجاهاته الفكرية»(أوردته الدكتورة يمنى طريف الخولي، في كتابها: فلسفة كارل بوبر: منهج العلم … منطق العلم، الهيئة المصرية العامة للكتاب (الطبعة الثانية)، القاهرة (200)، ص.16، كما أن اشتغاله بالنجارة بإشراف نجار أميَلَ إلى الوثوقية والتعصب لرأيه، جعله يُعلِي من أهمية الخطأ وكيف أن إبعاد الخطأ يترتب عليه إبعاد الحقيقة أيضًا، كما أن اشتغاله بمهنة التربية والتعليم، واشتغاله مساعدًا في عيادة الطبيب النفسي ألفريد أدلر الذي أنشأ أول عيادةً للتوجيه في مدارس فيينا، وأنشأ مدرسةً تجريبيةً فيها، جعله يعي مدى أهمية التربية؛ يقول بوبر: «نعم، كنت أستاذًا(…) ومهمة التكفل بالأجيال الجديدة مهمةٌ من أسمى المهام»، من حوارٍ أجرته مجلة إكسبريس مع بوبر، ونُشر في عددها لشهر فبراير1982، ترجمة الدكتور محمد سبيلا، (د. محمد سبيلا، في الفكر المعاصر(حوارات)، منشورات دارما بعد الحداثة، الطبعة الأولى، فاس (2006) ص: 108.)
[3] ما يسترعي الانتباه هو أن كارل بوبر بالرغم من إعداده لأطروحته في علم النفس، ومع أنه اشتغل مساعدًا دون أجر، كما سبقت الإشارة، لألفريد أدلر في عيادته، إلا أنه سدّد نقده القاسي لهذا التخصّص بِبيانِ اتصاف أغلب نظرياته بالعلمية الزائفة كما هو الحال بالنسبة لنظرية أدلر المبنية على القول بالتعويض عن عقدة النقص والشعور بالدونية أو نظرية أستاذه سيغموند فرويد، بل حتى النقد الذي وجّهَهُ إلى ما يسمى بالمنطوقات أوالعبارات القاعدية، حين نقده للوضعية المنطقية، إنما كان بحكم مضمونها النفساني.
[4] الكتاب العمدة لكارل بوبر و”إنجيل” إبستيمولوجيته النقدية، منذ أن صدرت طبعتُه الأولى باللغة الألمانية سنة 1934، والأولى باللغة الإنجليزية سنة 1959، تلاحقت طبعاته، وفي كل طبعة يتم تحينه بالإضافة من قبل بوبر، في صورة ملحقات، ليكون بذلك، بمثابة وثيقة شاهدة على ما شهدتْهُ إبيستيمولوجيا بوبر من تطوير، وهو أمر نادر، يدل على أن دليل نقديّة البوبرية هو ما مارسته من نقدٍ على ذاتها، دون أن يمنع من وجود نقط عمياء أخرى، كتلك التي يركز عليها المقال المُترجَم. (م).
[5] من المفاهيم الأساسية لكارل بوبر، وهو يمثل إلى جانب التكذيب، أحد مَصيرَي النظرية اللذين لا ثالث لهما، حين مواجهة ما نستنبطه منها بالواقع، وهو يشير إلى اجتياز النظرية لمزيد من التجارب الفاصلة والاختبارات الحاسمة وبقائها صامدةً دون استبعاد.
[6] عارض بوبر الاستقراء سواءً باعتباره منهجًا أو منطقًا، فبالنسبة له لا يمكن أن نجد تبريرًا للاستقراء إلا على أساس مبدأ استقرائي آخر، مما يفضي بكل محاولة تريد تبرير الاستقراء إلى السقوط في الدّور المنطقي. والمسألة في تناول بوبر تبقى على علاقة بما يسميه معيار التمييز أو الحد الفاصل الذي يميز العلم عن سواه، وكما تقول طريف الخولي، لو أردنا تلخيص فلسفة بوبر في كلمة واحدة لكانت ضد الاستقراء أو (اللاّاستقراء)، فما من محاضرة يلقيها أو مقالة يكتبها إلا ويؤكد فيها أن الاستقراء خرافة”، الخولي يمنى طريف، فلسفة العلم في القرن العشرين، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، ،2000ص، 333).
[7] ترجمته إلى اللغة العربية أنجزَها الدكتور السيد نفاذي، وصدرت في طبعتها الأولى عن دار التنوير للطباعة والنشر (لبنان)، 1998
[8] حري بنا الإشارة إلى أن هذا النادي أدى دورًا كبيرًا على مستوى التطورات التي شهدها حقل البيولوجيا أو علم الأحياء في علاقته بالفلسفة، والصراع الذي كان قائمًا داخله بين النزعة الحيوية والنزعة الميكانيكية والنزعة العضوية التي كان ينتصر لها النادي، للمزيد من التوسع يُراجَع:
- Erik L. Peterson The Life Organic : The Theoretical Biology Club and the Roots of Epigenetics (Pittsburg: University of Pittsburgh Press, 2016).
[9] غريغور يوهان مندل Gregor Johann Mendel)( 1822- 1884) راهبٌ أوغاستيني وعالمٌ نمساوي، ومؤسس علم الوراثة الحديث. وفي العلاقة بين إسهامِهِ ونظرية التطور؛ يظهر أن الفكرة التي أتى بها وكأنها تقوض كل ما كان داروين يسعى إلى إرسائه، لأن من بين ما تنص عليه قوانين الوراثة التي صاغها، هو أن «العوامل الوراثية ثابتة، لا تتغير ولا تتأثر على توالي الأجيال».
[10] مصطلح «حسد الفيزياء» تعبير يتم استخدامُه لأجل انتقاد كتابات العلماء أو الأكاديميين العاملين في مجال «العلوم الرّخوة»، لإفراطهم في استخدام الرياضيات والمفاهيم المعقدة لتظهر أقرب إلى الفيزياء، التي تثير الحسد إما افتراضًا أو حقيقةً، بحكم الدقة الرياضية التي تميِّزُ مفاهيمها الأساسية، وهو أمرٌ يعضدّه على المستوى الواقعي لا النظري، التّفاوت الكبير في قيمة المنح التي رُصدت وتُرصد للمتخصصين في العلوم الطبيعية مقارنةً بمثيلتها المخصَّصة لأصحاب العلوم الاجتماعية والإنسانية.
[11] مفهوم أساسي في فلسفة كارل بوبر هو الذي يردِمُ الهوّة بين دائرة ثقافة العلوم الاجتماعية والإنسانية ونظيرتها الخاصة بالعلوم الطبيعية، لأن، وحدة المنهج بينهما قائمة بحسب كارل بوبر، ما داما ينطلقان معًا من تخمينات، مع محاولة تفنيدها، ليكون الاختلاف، والحالة هذه، بين العلوم الإنسانية والطبيعية اختلافًا في الدرجة لا في نوع المنهج المتّبع، إن صح التعبير.
[12] فريدريش أوغوست فون هايك (1899-1992) فيلسوف وعالم اقتصاد نمساوي بريطاني، حصل على جائزة نوبل في الاقتصاد برسمٍ سنة 1974، من أكبر منظري الليبرالية الجديدة وأشرس المدافعين عنها.
[13] عبارة عن منتدى للتفكير يعود تأسيسه إلى سنة 1947، أعضاؤه من رجال الاقتصاد والمثقفين والصحفيين.
المصدر (وفق اتفاقية خاصة بين مؤسسة معنى ومجلة إيون).
 كن جزء من مجتمع مرّرها اشترك بنشرتنا.
كن جزء من مجتمع مرّرها اشترك بنشرتنا.