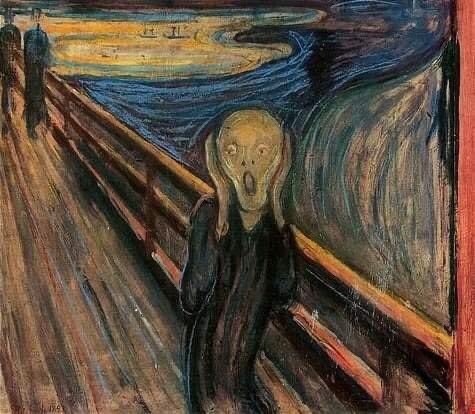
ترجمة: محمد حسين – تحرير ومراجعة: بلقيس الأنصاري
حظيَ مفهوم “التنوع العصبي” Neurodiversity بنفوذٍ ثقافيّ هائل في السنوات الأخيرة. فبعض علماء الكمبيوتر والخبراء التقنيين يضعون بفخرٍ على ملابسهم بطاقة “مختلف عصبيًّا neurodiverse”، فيما تعمل الشركات والأعمال التجارية على بناء قوىً عاملة “مختلفة عصبيًّا”، ويسعى كُتَّاب السيناريو جاهدين إلى تمثيل الأشخاص “المتباينين عصبيًّا neurodivergent”. فقد مُنِح هؤلاء الذين يُصنَّفون على أنهم “مختلفون” عدسة لافتة جديدة يتم من خلالها إعادة تصوّر ذلك التنوع والاختلاف.
صكَّت عالِمة الاجتماع جودي سنغر مصطلح “التنوع العصبي” في تسعينيات القرن العشرين. مُستلهمةً بعض حركات التحرّر الاجتماعي الأخرى التي تركز على العِرق والنوع، استغلّت سنغر موقفها كشخص مُصاب بالتوحد لاستقطاب المختلفين عصبيًّا للانضواء معًا تحت وسمٍ واحد، وكان هذا إلى حدٍّ ما رد فعل على ما وصفته سنغر بالرؤية “البنيوية الاجتماعية” للتوحد، حيث ترى أنه لا يوجد أيّ أساس بيولوجي قوي لهذه الحالة، ما ترتب عليه إنكار الاختلاف العصبي كواقع قائم، على حد تعبير سنغر. وردًّا على ذلك، قدَّمت سنغر مصطلح “التنوع العصبي” تحت مظلَّة التنوع البيولوجي؛ بمعنى أنه يعترف بالاختلاف الطبيعي بين البشر ويحترمه ويُقدّره.
سرعان ما حازت المبادرة على الدعم عبر المنتديات على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي الجديدة. ومنذ أن استعملت سنغر مصطلح “التنوع العصبي” لأوّل مرة، توسّع المصطلح متجاوزًا التوحد ليشمل مَن يُصنَّفون ضمن فئات مثل اضطراب فرط الحركة، ونقص الانتباه (ADHD)، وعُسر القراءة Dyslexia، واضطراب ثنائيّ القطب، والاكتئاب، وغير ذلك. وهكذا، بلغ الأمر بالتنوع العصبي ليعني أيّ اختلافات ذهنية -لا هي اختيارات طوعية ولا هي أمراض ببساطة- ليست مشكلات تحتاج إلى حلول بقدر ما هي إثراء للمجتمع. لقد أنجز التنوع العصبي عملًا مذهلاً من جهة تحطيم الحواجز الاجتماعية، وذلك بالتصديّ لعملية الوصم ورفع الوعي، غير أنه في الوقت ذاته ينطوي على بعض جوانب القصور الآخذة في الظهور ولَفْتِ الأنظار بصورةٍ متزايدة مع توسّع المصطلح وامتداده إلى مجالات ودوائر جديدة.
المقدِّمة الأساسية لمبادرة التنوع العصبي هي أن المجتمع ينبغي أن يكون صلبًا إلى حدِّ تقبّل جميع الناس والاحتفاء بهم بصرف النظر عن طبيعة “التكوين العصبي” للمخ. هذا هدفٌ محمود جدير بالثناء ويجب ألا يكون صعبًا مستعصيًا على فهم أيّ أحد. ومع ذلك، ومنذ انطلاق مبادرة التنوع العصبي، قال بعض منتقديها: “إن شعارها المتمثّل في القبول الجذريّ التام؛ قد يحول دون تقديم أشكال العلاج والتدخلات اللازمة لمَن يُعانون”. ذلك أنهم يقولون: “إنّ تقبّل فكرة التباين العصبي بحماسٍ مُبالَغ فيه؛ ينشأ عنه خطر صرف الانتباه عن الاحتياجات الحقيقية: المادية أو الشعورية أو الاجتماعية، التي تتطلَّب الانتباه”.
سرعان ما يتردَّى هذا الجدال ويؤول إلى تبادل الاتهامات، لكنه في الوقت ذاته يصرف الانتباه عن مشكلةٍ فلسفية أعمق لا بد لمبادرة التنوع العصبي من مواجهتها مع توسّعها وامتدادها إلى نطاقاتٍ جديدة. تستند رؤية الاحتواء لدى التنوع العصبي -وهي رؤية جذابة ومُغرية في حقيقة الأمر- إلى فكرة أن التركيب العصبي هو أصل كل الاختلافات في طبيعة علاقة البشر بالعالَم. غير أن ردَّ التنوع والاختلاف إلى تمايزات بحسب تركيب المخ قد يكون عائقًا أمام طُرُقٍ أكثر حساسية ويمكن أن تكون أكثر جدوى لفهم الحياة الذهنية. في واقع الأمر، لقد فضح نجاح التنوع العصبي الغياب الصارخ لأيّ رؤية مشتركة أو أيّ شكل من أشكال التضامن حول الاختلاف الذهني، الذي لا يقوم على مقارباتٍ وتفسيراتٍ تعتمد على تركيب المخ. لذلك، في حين أننا نستطيع الإشادة بروح التقبّل لدى مبادرة التنوع العصبي، إلا أنه ينبغي لنا أن نرتاب في التزامها بإثبات شرعيّتها من خلال يقينياتٍ “عصبيّة” زائفة.
ثمَّة مسَار مختلف للمُضيّ قُدُمًا، وفيه نُشكّل انتماءنا السياسي وتفكيرنا العلمي بناءً على “الذهن” وليس المخ. وأنا أطلق على هذا البرنامج مسمَّى: “التنوع النفسي psydiversity”. يرفض برنامج التنوع النفسي الادعاء القائل: إن الحالات الذهنية يمكن تمثيلها وربطها بالمخ بصورةٍ تامة وبشكلٍ قابل للتنبؤ. وبدلًا من ذلك، يدعم البرنامج الجهود القيمة لمبادرة التنوع العصبي ببيان أن العمليات الذهنية وطريقة فهمنا لها تتغير وتتطور عبر التاريخ. في الواقع، يؤكد التنوع النفسي على أن كلًّا من الذهن و”الطبيعة البشرية” ليس شيئًا كاملًا قائمًا بذاته، إنما شيء يمتد بعمق، بل وتشكَّل من خلال المجتمع والسياق الذي يظهر فيهما. هذا لا يعني إنكار وجود الاختلاف كحقيقة واقعة، ولكن بالأحرى وضع هذه الحقيقة بوصفها جزءًا من صيرورةٍ اجتماعية وتاريخية آخذة في التكشّف والانفتاح.
إذا كان هناك جانب واحد من “التنوع العصبي” يمثّل جوهر برنامجها، فهو تعبير “عصبي neuro”. التعبير مشتق فعلًا من الكلمة اليونانية القديمة “neûron”، أو من الكلمة اللاتينية “nervus”، التي تشير إلى الأعصاب أو الجهاز العصبي. وتعود جذور المقاربات الراهنة في علم الأعصاب إلى أوائل القرن التاسع عشر، حين جمع بعض علماء الفسيولوجيا، مثل: فرانز جوزيف غال وتشارلز بيل وفرانسوا ماجندي، بين دراسات تشريحية على الإنسان وبعض عمليات التشريح التجريبية المُرعبة على الحيوانات من أجل تحديد العلاقة بين المخ والنخاع الشوكي والجهاز العصبي. وبحلول القرن العشرين، كان علماء الأعصاب قد وضعوا خرائط تفصيلية للمخ والجهاز العصبي، كما شخَّصوا ووقفوا على عدة حالاتٍ طبيّة بارزة، مثل: الشلَل الدماغي والشلَل النصفي.
ومع ذلك، لم تشرع علوم المخ في أن تجد لها موطئ قَدمٍ حقًّا داخل فروع وحقول المعرفة البشرية الأخرى إلا في تسعينيات القرن العشرين. ذلك أنه عبر تقنيات التصوير الجديدة والفحوص الوراثية الجديدة ظهرت شواهد تشير إلى أن صور التفاوت والاختلاف في انفعالات البشر وسلوكياتهم لعلّه يرجع إلى اختلافاتٍ قائمة في المخ لدى البشر. وهكذا نشأ عدد كبير من الموضوعات البحثية المتباينة التي يلحقها وصف “العصبية” مثل: التربية العصبية neuroeducation، والأخلاقيات العصبية neuroethics، والأنثروبولوجيا العصبية neuroanthroplogy، والجماليات العصبية neuroaesthetics، والقانون العصبي neurolaw. وقد أطلق الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش على عقد التسعينيات من القرن العشرين: “عقد المخ”، بينما أعلن الفيلسوفان فيرناندو فيدال وفرانشيسكو أورتيغا أن علوم الأعصاب أدَّت بنا إلى الاعتقاد بأن “الإنسان هو المخ”.
نشأ هذا كلّه عن الاعتقاد بأن العلوم القائمة على دراسة المخ والأبحاث الوراثية قد تنقل المجتمع إلى حالٍ أفضل. وحين أعلن عالِم الوراثة الهولندي هان برونر أن حدوث خلَل في الجين MAOA؛ قد يكون سببًا في النزوع المتزايد إلى العنف، أدَّى هذا إلى بعث الآمال في أن تتحوّل الأحكام الأخلاقية بشأن “الخير” و”الشر” والسلوكيات المتعلقة بهما إلى بحوثٍ ومعالجاتٍ عِلمية تقدميّة. ومن ثمّ، لن يكون هناك “أشرار” بعد الآن، وإنما مجرد صور من الخلَل والاضطراب في عمل المخ. فإذا كان من الممكن الوقوف على كيفية نشوء الدافع الإنساني على المستوى الجزيئي، فمن الممكن أيضًا تغييره.
منذ تسعينيات القرن العشرين، تمثّل حُلم علم الأعصاب في إمكانية ربط السلوكيات الاستثنائية و”الاضطرابات الذهنية” بأحوال المخ، ومن ثمّ علاجها تبعًا لذلك. بَيْد أنه في واقع الأمر، نجد أن معظم الحالات المُشخَّصة في الطب النفسي ليست مستقرة أو ثابتة، وليس لها “علامة مميزة” في المخ، وغالبًا ما يكون علاجها صعبًا للغاية. أضف إلى ذلك أن التطورات الحادثة في مجال العقاقير قد سبقت في الغالب ضبط وإحكام التصنيفات المَرَضية في الطب النفسي، ومن ثَمّ، وهو الأمر المقلق، يؤدي العلاج بالعقاقير إلى مزيدٍ من الحالات المُشخَّصة، وهو نقيض حُلم علم الأعصاب. وهذا هو ما حدث بالفعل في حالة اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، حيث توافق تطوير العلاج بمشتقات الأمفيتامين مع زيادات كبيرة في الحالات المُشخَّصة، وكذلك كانت معدلات الاكتئاب مُتماشية مع إنتاج عقار بروزاك وغيره من العقاقير المُضادة للاكتئاب.
الحقيقة المُحيّرة هي أنه بمجرد ظهور علاج أو أداة طبية، تتجه القوى الاجتماعية والمالية والسياسية إلى رفع وزيادة التشخيصات. فالدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية (DSM) -الكتاب المرجعي الذي يُعَدّ أساس معظم تشخيصات الطب النفسي في عالَم الواقع، وكذلك معظم الدراسات المَعمليَّة الخاصة بعلم الأعصاب- هو أداة تشخيصية معصومة من الخطأ بشكلٍ مطلق، على حدّ تعبير الطبيب النفسي ألان فرانسيز وغيره. وقد تروّج شركات الأدوية لنظرياتٍ تقول: “إنّ دراسات المخ والدراسات القائمة على العلاج بالعقاقير ستكون البَلسم الشافي والعلاج الناجع لكل أشكال المعاناة الذهنية، غير أننا لا يزال أمامنا طريق طويل، طويل للغاية، حتى تكون هذه الدعوى حقيقة واقعة.
في حين أن هذه الثورة “العصبية” لم تؤتِ ثمارها بعد، إلا أنها فتحت الباب لأحلامٍ وطموحاتٍ جديدة. وهذا هو السياق الذي ظهرت فيه مبادرة “التنوع العصبي” إلى حيّز الوجود. ومع أن مؤيديّ التنوع العصبي قد يوجهون بعض النقد للأنماط السائدة الشائعة من علم الأعصاب والطب النفسي، إلا أنهم أقاموا حلفًا مثيرًا للفضول مع هذه الحقول العلمية ذاتها. وانطلاقًا من إعادة تصويرها للتوحد من منظورٍ جديد، سَلَّطَت مبادرة التنوع العصبي الضوء على الشرعية العلمية لكلٍّ من العلوم العصبية، والدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية (DSM)، وذلك من دون اعتراف حقيقي بالانتقادات الأخرى والتفسيرات الأخرى المُنافسة بشأن حياة الإنسان الذهنية.
ومن العجيب أن التوحد نفسه يظهر على نحوٍ فريد استثنائي في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية (DSM). فما مِن تشخيص آخر انتشر بهذه السرعة خلال عقدَيْ الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين. والأهم من ذلك، أن انتشاره لم يكن له علاقة بإنتاج العقاقير كما هو الحال مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والاكتئاب. وتصنيف التوحد يبدو أمرًا غريبًا شاذًّا، إلا أنه من المثير للسخرية أن هذا الشذوذ ذاته هو ما أطلق شرارة مبادرة التنوع العصبي بأسرها، وهي الآن آخذة في النموّ والتوسع لتستوعب تحت عباءتها عددًا متزايدًا من التشخيصات الأخرى الموجودة في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية (DSM).
حين انطلقت مبادرة التنوع العصبي، كان تجاهلها للعلوم السيكولوجية الموجودة مِن قَبل أمرًا مقصودًا متعمدًا إلى حد كبير. وبوصفها سيدة مُصابة بالتوحد في تسعينيات القرن العشرين، أرادت جودي سنغر تعريف هويتها على لوحةٍ خالية نظيفة، وهذا أمر مفهوم. فقد كان الخطاب السائد بشأن التوحد يتضمن في الغالب توجيه اللوم للآخرين للتسبب في ظهور هذه الحالة لدى أطفالهم، وذلك بالاستناد إلى أعمال عددٍ من علماء النفس الذكور خلال حقبة ما بعد الحرب العالمية، مثل برونو بيتلهايم. وبحلول السبعينيات، أعلن جيل جديد من علماء النفس أن تلك الدعاوى غريبة واهية؛ لأنها لم تتمكّن حتى من وضع تعريفٍ واضح للتوحد. ومن ثمّ عمَلت لورنا وينغ -وهي إحدى علماء النفس وأمٌّ لطفلة مصابة بالتوحد- بلا كلل لتصحيح هذا الانحراف المفاهيمي؛ بوضع تعريفٍ قياسي للتوحد بوصفه نوعًا من القصور في الحياة الاجتماعية والتواصل مع الآخرين. كان هذا هو التعريف الذي انعقد الأمر على إثباته في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية (DSM)، ما أدَّى بدوره إلى استدعاء تفسيراتٍ وراثية للتوحد.
ولأن سنغر التقت بتلك التوصيفات والتعريفات جميعًا ومرَّت بها، فقد كانت في وضعٍ يؤهلها لصياغة دعاواها الخاصة بشأن هويتها هي نفسها وما وصلت إليه. لم تكن ترغب في الأخذ بنماذج سابقة وَصَمَتْ الأمهات والفروقَ السيكولوجية الطفيفة بعدم السويَّة وبتوصيفاتٍ مَرَضية. وكذلك لم تكن ترغب أيضًا في الأخذ بتعبيرٍ يصف الشخص بأنه “ذو عاهة”. ومن ثَمّ أتاحت مبادرة التنوع العصبي شكلًا جديدًا من الهوية المتميزة من الناحية السيكولوجية، لكنها لا تنظر إلى ذويها على أنهم يُعانون من نقصٍ بطريقةٍ ما.
إنّ التصنيفات والمقولات السياسية دائمًا ما تكون انعكاسًا للظروف التي تنشأ فيها. أحسَّت سنغر أن هويتها السياسية مُهدَّدة، ولذلك سرعان ما أنشأت إطارًا جديدًا لتشيّد عليه هوية سياسية جديدة. وكما أوضحتُ من قبلُ، فقد أُفسح بعنايةٍ للتشخيص بالتوحد مكان داخل نموذج الليبرالية الجديدة للرفاه الاجتماعي خلال تسعينيات القرن العشرين، حيث لم يكن يحصل على كافة أشكال الدعم الاجتماعي إلا مَن هُم ذوو إعاقات اجتماعية معينة أو “عاهات” محددة. ففي بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا وأماكن أخرى، حين اجتمع هذان العاملان معًا كما في حالة التشخيص بالتوحد فإنهما شهدا ظهورًا وارتفاعًا سريعًا بالتوازي مع تدمير دولة الرفاه الاجتماعي التي نشأت في حقبة ما بعد الحرب العالمية. ولذلك، حين نادت سنغر بالتمثيل السياسي للمصابين بالتوحد في تسعينيات القرن العشرين، لم يكن بمقدورها أن تفعل ذلك إلاّ لأن المصابين بالتوحد أصبحوا بالفعل فئة سياسية. وما كان من سنغر إلا أنها جمعت الحشود والمجموعات المتفرقة، تحت لافتة التنوع العصبي.
ما المشكلة في التفسيرات القائمة على تركيب المخ أو التفسيرات “العصبية” أيًّا ما كان؟ تتأسَّس جميع التوضيحات والتفسيرات من هذا النوع على المقدِّمة التي تقول: “إنّ المخ يوفر لنا إمكانية الوصول إلى واقعٍ علمي حقيقي يمكن إسقاطه فيما بعد على العالَم الخارجي لتفسير القدر الشاسع والمدى الهائل للخبرة الإنسانية”. هذا الأمر يُشبع توقنا إلى الحقائق المُطلقة واليقينيات، بل قد يكون أساسًا للتضامن وظهور هويات ذات مغزى ودلالة. إلا أن المقولات والتصنيفات الإنسانية دومًا ما تكون أحوالًا عابرة طارئة مضطربة وغير يقينية. وفي حقيقة الأمر ثمَّة عدد من النماذج العلمية الأخرى والفرضيات التي تعمل بكفاءةٍ قد تساعدنا على فهم النموّ السيكولوجي واستيعابه، رغم أن سنغر لم تُعِرها الاهتمام الكافي ووضعتها في درجةٍ متأخرة. أقصد بذلك العلوم التي نعرّفها اليوم الخاصة بـ “النفس psy”، مثل علم النفس والتحليل النفسي والطب النفسي والعلاج النفسي. وكما أن لفظ “العصبي neuro” ذو أصل يوناني يشير إلى الأعصاب nerves، فكذلك لفظ “النفس psy” ذو أصل يوناني يشير إلى النفس psyche بمعنى النفس أو الذهن أو الحياة.
ظهرت علوم “النفس psy”، التي نعرفها اليوم خلال العقود التي تمثّل أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، مدفوعة بـ “اكتشاف” فرويد للاوعيّ. لقد نسف فرويد الأفكار الغربية المُريحة بشأن العقول الرشيدة التي توجّه التاريخ الإنساني على دربٍ يمضي قُدُمًا نحو التقدم والتنوير. وبدلًا من ذلك، طرح فرويد نظرية عن الدافع الباطن اللاواعي، حيث تُحرِّك الكائنَ البشري دوافعُ غريزية متأصِّلة. وقد كان لهذه المبادئ والأفكار تأثير عميق على المربّين والبيروقراطيين والحكومات في مختلف أرجاء العالَم.
طوال القرن العشرين تقريبًا، هيمنت علوم “النفس psy”، على عملية صياغة نظرياتٍ عن المخ والجهاز العصبي. وساعد وضع اختبار نسبة الذكاء IQ في فرنسا عام 1905 على تمهيد المَشهد وإعداده لانتشار العلوم السيكولوجية بشكلٍ هائل. ففي أوائل القرن العشرين، بدأ تأسيس المختبرات والمعاهد والأقسام السيكولوجية، وشرع علماء النفس في تمييز أنفسهم كفئة مهنية متخصِّصة. ومما ساعد على هذا الانتشار ظهور التعليم الإلزامي وتطوير تقنيات تواصل جديدة مثل: السينما والإذاعة والتلفزيون في الأنظمة الديمقراطية الحديثة. وقدَّمت علوم “النفس psy” إسهامات ضخمة في جميع عمليات التنظير عن النفس والهوية، وظلَّت مؤثّرة في حوكمة الحياة اليومية عبر الخدمات الاجتماعية والطبية والقانونية. فمثلًا، عمل إنشاء محكمة الأحداث juvenile court، في بريطانيا عام 1908، على التأليف بين المتخصّصين في علوم “النفس psy” والمتخصصين في القانون؛ من أجل إعادة صياغة وفهم جرائم الأحداث والقاصرين من منظور الدافع السيكولوجي وليس السقوط الأخلاقي. كما شجعت على إعداد البرامج السيكولوجية في المدارس والمراكز الصحية وأقسام الخدمة الاجتماعية، وهو نموذج سرعان ما أخذت به دول صناعية كثيرة.
بشكلٍ حاسم، وجَّهت علوم “النفس psy” اهتمامًا خاصًّا لكيفية تبنّي الذهن لدوافع غريزية من أجل مجاراة الحاجات التي تفرضها عليه “الحضارة”، حيث قدَّمت منظورات جديدة بشأن الضغوط الناشئة عن التصنيع والحداثة. ولذلك، حين أعرض مؤيدوّ التنوع العصبي عن النظريات السيكولوجية في تسعينيات القرن العشرين، فإنهم بذلك ابتعدوا عمَّا هو أكثر من مجرد نظريات بيتلهايم رديئة الصياغة حول الحبّ الأموميّ. كما أن التشبثّ بالتفسيرات “العصبية” بشدة لا يترك سوى مساحة ضئيلة لنظرياتٍ أوسع حول الدافع اللاواعي، وكذلك، وبطرقٍ عديدة، للعلوم الاجتماعية إجمالًا، إلى حدٍّ يطال أيضًا تلك العلوم التي تسعى إلى تحديد الأنظمة الضمنية للفكر والأيديولوجيات التي توجّه السلوك الإنساني.
ما ترتّب على تطوير نماذج جديدة في علم الأعصاب خلال تسعينيات القرن العشرين، وما صاحب ذلك من ظهور الإنترنت وتقنيات التواصل الاجتماعي، أنه حفّز ظهور سياسات جديدة للهوية زعزعت استقرار الشبكات المهنية المتعلقة بـ “النفس psy” الموجودة مِن قَبل ورسَّخت نماذج جديدة للهوية. من المؤكد أن هذه تطورات مهمة وضرورية، إلا أنه سيكون من السذاجة الاعتقاد بأنها ستحلّ محلّ بعض المبادئ الجوهرية الأساسية التي شكَّلت صور الفهم الأكثر شمولًا واتساعًا للسلوك الإنساني طوال أكثر من قرنٍ من الزمان. ومن المهم والضروري الإقرار بقيمة ما أنجزته مبادرة التنوع العصبي من دون الإذعان -بغير علم- للأبعاد والمنظورات الجامدة لفئةٍ من المجتمع تأخذ برؤيةٍ “عصبية” مؤسِّسة بشكلٍ كامل على تركيب المخ.
تاريخيًّا، تحركت كل من العلوم العصبية وعلوم “النفس psy” صوب تسويغ أشكال من الظلم الاجتماعي على نطاقٍ واسع في الدول الديمقراطية، بداية من التعقيم القسري والعلاج بالبهورمونات وصولًا إلى “علاج” الممارسات الجنسية الشاذة. ويجب ألّا نقع هنا تحت طائلة أيّ صورة من صور الأوهام والخداع. ومع ذلك، لا يُعقَل أن نُشوِّه سمعة أحد القسمَيْن من العلوم ونمجّد الآخر. ففي حقيقة الأمر، غالبًا ما كان علماء النفس يأخذون بمقاربة “أكثر لطفًا” تنطلق من فهم الدوافع الإنسانية ما ساعد في تلاشي مقارباتٍ أشد قسوة ووحشية قائمة على اختلاف تركيب المخ. فعلى سبيل المثال، بينما قام مختصّون بتحسين النَّسل -مثل: كارلوس بلاكر في بريطانيا- بالموازنة بين “القصور العقلي” والوفرة الاجتماعية والاقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية؛ من أجل الدفاع عن إجراء عمليات التعقيم، كان هناك علماء نفس، مثل: نيل أوكونور وبيت هيرملين، حاججوا بأن التدخلات السيكولوجية والاجتماعية دومًا ما تكون أفضل وأجدى.
ومن العجيب أن من انتقدوا علوم “النفس psy” مِن قَبل نادرًا ما سعوا إلى التخلّص من المعرفة السيكولوجية بشكلٍ جذري. خذ مثلًا من كانوا في طليعة مؤيديّ مبادرة التنوع العصبي، مثل مبادرتَيْ: “ضد الطب النفسي”، و”الناجون من الطب النفسي”، اللتَيْن ظهرتا في خمسينيات وستينيات القرن العشرين، حيث وجّهوا انتقادات حادة لطريقة تعامل منظومة الطب النفسي معهم من الناحية المَرَضية وكيف ألحقتْ بهم الأذى والضرر، إلا أنهم، فيما يتعلق بالحالات الذهنية، ظلّوا رافضين بكل حزم لكل التفسيرات العصبية أو المؤسَّسة على تركيب المخ. هذا الرفض يرجع جزئيًّا إلى حركةٍ مضادة ظهرت بعد الحرب العالمية ضد صور فهم العلل الذهنية أو القصور العقلي، وهي إما قائمة على توجه نحو تحسين النَّسل أو صور تقليدية متوارثة، وقد ارتبطت كلها بالنازية. أسهمت هذه الحركة المضادة في ازدهار النظريات “البنائية الاجتماعية” بشأن الحالات الذهنية في أواخر السبعينيات وخلال الثمانينيات من القرن العشرين، وذلك من خلال المؤسسات الخيرية والجامعات وصناعة النشر المزدهرة. وفي هذا بيّنة وبرهان على المدى الذي وصلنا إليه، حيث نجد أن بعض مؤيديّ التنوع العصبي، مثل جودي سنغر، قد يستوعبون حتى ولو أبعادًا وجوانب هيّنة صغيرة من علم الأعصاب وعلوم الوراثة كجزء من حركةٍ اجتماعية جديدة، ناهيك عن مَن يؤيدون بشكلٍ جذري النظريات المؤسَّسة على تركيب المخ.
كان مناهضوّ الطب النفسي يعرفون أن علوم “النفس psy” أدّت دورًا مهمًّا في تأهيل الناس ودعمهم، حتى وإن كانت هذه العلوم قد وُظِّفت على نحوٍ بائس فيما مضى. وبطرقٍ عديدة مختلفة، قامت حركة “ضد الطب النفسي” بدمج مبادئ أساسية من التحليل النفسي عبر توظيف المعرفة التاريخية، وذلك من أجل إقناع الناس ودفعهم إلى انتقاد ممارسات علماء النفس. كان هذا الأمر بمثابة نمط من النشاطية التي استفادت من التحليل النفسي والمعرفة التاريخية. فبدلًا من تشويه سُمعة العلوم السيكولوجية وتسفيهها، قام الفيلسوف ميشيل فوكو وآخرون بمبارزة علماء النفس بنفس منطقهم ومناهجهم، فلربما كان لسان حالهم يقول: “إذا كنتم ستحلّلون مِن أين نشأت ’مشكلات‘ هويتي، إذن سأحلّل أنا أيضًا مِن أين نشأت هويتك وشرعيتك وسُلطتك”. لقد كان هذا ينمُّ عن دهاءٍ وفطنة؛ لأنه بهذا لم يقتصر على تحرير القيود التي وضعها المتخصّصون في “النفس psy” على شخصيتهم الفردية، وإنما أيضًا كشف كيف حازت العلوم السيكولوجية سُلطة عبر خبراء ومؤسسات وسياسات سيكولوجية.
إنّ ما أطلق عليه فوكو: “الأنطولوجيا التاريخية” -دراسة ما يجعل وجود شيء أو ظهوره إلى حيّز الوجود في وقتٍ لاحق أمرًا ممكنًا- أكّد أهمية التاريخ والفكر الجمعي لفهم العقل المعاصر. وبطريقةٍ أو بأخرى، لم يكن هذا إلّا صورة مُنقحة ودقيقة للغاية من علم نفس التأمل الذاتي. فما بيّنه هو أن العقل موضوع قائم في التاريخ دائمًا، بغض النظر عن حالاته “العصبية”. وهكذا، تقبل التعددية النفسية psydiversity بأن العقول متشابكة ومتداخلة مع المجتمعات المحيطة بها ولا يمكن اختزالها وردها إلى مجرد اختلافاتٍ من منظور علم الأعصاب، وهذه الاختلافات على أيّة حال، هي نتاج فرعي أيضًا للعصر والزمن الذي تنشأ فيه. ومن ثمّ، تنقلنا التعددية النفسية إلى خطوةٍ أبعد لنتجاوز الاعتماد السقيم على المعرفة التي تحتكرها العلوم العصبية، وتمكّننا من دراسة الصعوبات التي تعوق توسع مبادرة التنوع العصبي وامتدادها لتستوعب كل صور الاختلاف بين البشر.
لا يعني أيٌّ مما سبق أن علوم “النفس psy” وصلت إلى درجة الكمال والمثالية، كما أن إعادة تنظيمها وتهيئتها لتتلاءم مع احتياجاتنا الراهنة يجب أن تتضمن أيضًا تقييمًا نقديًّا لتأثيرها على الديمقراطية والمجتمع. والإقرار بهذا التأثير ليس مِن قبيل المبالغة على الإطلاق. فعلوم “النفس psy” تمثّل، بطرقٍ عدة، حجر الزاوية في الديمقراطيات الحديثة. فهناك مفكرون، مثل: جان بياجيه وماريا مونتسوري وسوزان ساذرلاند إسحاق وأدوارد غلوفر وآنا فرويد، صاغوا كثيرًا من الأفكار التي أصبحت شيئًا أساسيًّا وجوهريًّا لتعمل الديمقراطية بكفاءة، مثل: مبادئ التعليم المبكر ومحاولات فهم سلوكيات الأطفال الخاطئة بدلًا من معاقبتهم. في يوم الناس هذا، أصبح المختصّون في الطب النفسي وعلم النفس والتحليل النفسي والعلاج النفسي بمنزلة جنود المُشاة في البلاد الليبرالية ذات الرخاء الاقتصادي. فمن خلال النظريات السيكولوجية، تعلّم الأفراد وصُنَّاع السياسة، على حدٍّ سواء، التحكم في دوافع البشر، والموازنة بين الحريات الديمقراطية للمواطنين، وضرورة وجود القوانين والقواعد الاجتماعية.
تسعى التعددية النفسية إلى رد الاعتبار للجوانب الإيجابية في مثل هذه المناهج، مع عدم تجاهل أقصى ما وصلت إليه من تقدّمٍ فيما مضى. وليست النظريات ذاتها هي أكبر مشكلات الحقول المعرفية “النفسية بالضرورة، وإنما المشكلة الكبرى هي احتمال استخدام تلك النظريات للدفاع عن صور ضيقة مقيدة مكبوتة للأسرة أو المجتمع أو الدولة. كما أن أحد أهمّ إنجازات مبادرة التنوع العصبي يتمثّل في فضح عدم منطقية كثير من تلك المقاربات والممارسات. وعلى سبيل المثال، أشار نشطاء، مثل: ستيفن كاب وداميان ميلتون إلى أن كَبت وإخفاء سلوكيات، مثل: العرّات tics [حركات أو أصوات لا إرادية غير مرغوب فيها]، والتحفيز الذاتي stimming [تكرار حركات جسدية أو أصوات أو كلمات]، لا يحدث عادة حرصًا على الشخص المعنيّ وإنما مراعاة للقواعد والأعراف الاجتماعية. وهذا أمر صحيح، ولا شكّ أنه لا بد من التدقيق باستمرارٍ في صور توظيف العلوم السيكولوجية، إلا أن التعددية النفسية تجعل هذا الأمر ممكنًا أيضًا من خلال استيعابها لنقدٍ ذاتي تاريخي؛ مُحافِظةً على وعي دؤوب بكيفية نمو المعرفة وتوظيفها ومنحها الشرعية، ولمصلحة مَن يجري هذا كلّه.
بَيْد أن “التعددية النفسية” لا تتخطَّى المراحل ببساطةٍ فتقفز إلى ضبط النماذج “النفسية” الموجودة مِن قبل، وإنما تسعى إلى استعادة المعرفة السيكولوجية لصالح مَن يُفتَرض أن هذه المعرفة وُجدت لأجلهم. ومن ثَمّ، هي تحثّ على إعادة صياغة جذريّة للعلوم السيكولوجية، مثل العلوم ذات طابع التاريخي وفي الوقت ذاته متنوعة وليست كتلة واحدة صمَّاء. وبدلًا من تقديم المختصّين في العلوم السيكولوجية على أنهم كهنة أو حكماء، تحثّ التعددية النفسية هؤلاء المختصّين على الإقرار بالأساس العلمي لمقارباتهم وممارساتهم وأن يكون هذا الأمر واضحًا ظاهرًا في كل خطوة من ممارساتهم: بداية من علوم الإحصاء التي يرتكز عليها الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية (DSM)، وبقايا الداروينية ونظرية الغريزة التي يرتكز عليها التحليل النفسي، وصولًا إلى استعارات الحوسبة التي ترتكز عليها علوم الإدراك المعرفي. وما مِن أملٍ لتغيير هذا التاريخ إلا عبر فهمه واستيعابه. لقد كان، وما زال، لعلم النفس دور في تشكيل فهمنا لأنفسنا، ولا يمكن ببساطةٍ تجاهل هذا الدور ورقابُنا في قبضة العلوم العصبية الجديدة.
خلاصة القول: “تُفسِح التعددية النفسية مكانًا لعلم النفس للتفكّر مليًّا في الجوانب اليقينية الدوغمائية للعلوم العصبية الراهنة”. صحيح أنها تُثمّن بشدة منظورات التنوع العصبي، إلا أنها في الوقت ذاته تدرك أننا نحيَا في عالَمٍ بحاجة إلى تجاوز سياسات الهوية وتطوير نماذج جديدة عن العقل. وبدلًا من تصوّر “الذات” على أنها قائمة في “المخ” فحسب، تتصوّر مبادرة التنوع العصبي عقولنا على أنها مُشكَّلة مِن خلال العلم، هذا صحيح، وفي الوقت ذاته من خلال القانون والمجتمع والتاريخ. وبشكلٍ قاطع، تُقِرّ مبادرة التنوع العصبي بأن المعاناة النفسية والذهنية حقيقية وموجودة بأشكالٍ مختلفة، وغالبًا ما تنشأ نتيجة لوصمةٍ وقعت على المرء أو تهديد لوجوده، ولها جذور وأصول تمتد عميقًا في ماضيه. وأن نتوقع أن علم الأعصاب وحده سَيَمُدُّ لنا يد العون هنا فهذا أمر لا جدوى منه.
شيئًا فشيئًا يصبح وسم “مختلف عصبيًّا neurodiverse” أكثر شيوعًا ومُطبَّقًا على نطاقٍ واسع. وهناك الكثير من العلماء المعاصرين المتخصّصين في العلوم السيكولوجية، مثل: فرانشيسكا هابيه الباحثة المتخصّصة في التوحد، يتحدثون دومًا عن التمييز بين المخ الطبيعي من الناحية العصبية neurotypical، والمخ المتباين عصبيًّا neurodivergent. وقد أثار هذا الأمر الكثير من النقاشات والحوارات بشأن الحالات التي تصلح، أو لا تصلح، لتكون “متباينة عصبيًّا”. وهذا بدوره يثير قلق بعض الباحثين، مثل محبّ قسطندي الباحث في علم الأعصاب الحيويّ سابقًا. إن إضفاء الشرعية على سُلطة وسم “مختلف عصبيًّا” قد يشجع البعض على تجنُّب العلاج أو الانخراط في أفكارٍ وسلوكياتٍ مدمِّرة، مثل: فقدان الشهية والحرص على ما يترتب عليه. ومع أن هذا لا علاقة له بالأهداف المعلَنة الخاصة بمبادرة التنوع العصبي ذاتها، إلا أن كونها تعوّل كثيرًا على رد الحالات إلى تركيب المخ يؤثر بوضوحٍ على تلك السرديات.
ولا يعني أيٌّ مما سبق أننا ننكر حِسَّ التضامن العميق الذي نمَا داخل مجتمع التوحد من خلال مبادرة التنوع العصبي، وهو ما وصفه ستيف سيلبرمان ببلاغةٍ في كتابه “قبائل عصبية” neurotribes(2015). لا شك أن تغيير القانون لتوفير أشكالٍ معينة من الحماية للمصابين بالتوحد كان أمرًا ضروريًّا وصائبًا، بيد أنني أتساءل ما إذا كنّا نريد حقًّا أن نشهد مجتمعًا تصبح فيه “القبائل العصبية”، التي تستمد مرجعيتها من دليل DSM هي الطبقات السياسية والاجتماعية الجديدة. يبدو لي أن هناك حدًّا للقيمة التي يمكن لمثل تلك المقولات أن تقدّمها من ناحية تعزيز ازدهار البشر جميعًا.
وكما تبيّن في حالة مبادرة التنوع العصبي، فغالبًا ما تستدعي التهديدات الموجهة إلى الهوية استجابات سياسية تجمع الناس وتوحدهم. غير أن التاريخ يعلمّنا أن تلك التهديدات تتغير بمرور الزمن، وأن كُلًّا من مقولتَيْ: “عصبي” و”نفسي”، تستجيب لهذا وتتغيّر بدورها. لا شيء يقينيّ الآن وللأبد، ولا حتى نموذج للتوحد مؤسَّس على تركيب المخ. وتحثنا التعددية النفسية على التفكير في كيفية دعم الناس بصرف النظر عن الهوية الفردية أو “العصبية” لكلٍّ منهم. إنها تقدّم منظورًا آخر يُمكِن من خلاله فهم الاختلافات بين الناس والاحتفاء بهم أيضًا. وبالنسبة لطفلٍ تمّ تشخيصه مؤخرًا باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، أو شخص بالغ تمّ تشخيصه باضطراب ثنائيّ القطب، ستقدّم التعددية النفسية لكلّ حالة بُعدًا آخر من الفهم فيما يتعلق بكيفية وصولها إلى تلك المرحلة.
وكما أن الباحثين المختصّين في القانون يدركون أن المواطنين هُم الجهة المنوط بها في نهاية المطاف تفعيل أيّ قانون عبر المنظومة التشريعية، تدرك التعددية النفسية أن الأفراد في آخر الأمر هُم مَن يفسر ويطبق أيّ معلومات مُستمَدة من علوم الأعصاب. ولا يمكن أن يحدث هذا إلا عبر تشارك المعرفة “النفسية” والاهتمام بها. وإذا كنّا نعترف حقًّا بأن حياة كل إنسان ذات قيمة وأهمية، فلا بد لنا أوّلًا أن ننظر إلى العقل الإنساني بكل أحواله سواء المرنة السلسة أو المعقدة المركبة بوصفه أداة وسيطة فيما بيننا وجزءًا لا يتجزّأ منّا، بدلًا من رؤيته كشيء مُنتَزَع، لا تاريخي، تمكّننا علوم الأعصاب من الانفصال عنه والوقوف خارجه. وتعتقد التعددية النفسية أن الخطوة الأولى على طريق فهم العقل لا بد أن تكون النقد الذاتي ومساءلة الذات. وهذا الأمر يتطلب نمطًا من علم النفس يكون على وعيّ بتاريخه، يدرك التنوع والاختلاف ويقدّره، ولا يقتصر على مجرد التشبث والتقيد بمقولات علم الأعصاب الموجودة مِن قبل. بعد التنوع العصبي، تقع على عاتقنا مسؤولية استكشاف المضامين والتأثيرات الأوسع للطرائق والكيفيات التي يفكر بها البشر. ويتمثّل التحدي في أن نُنجز هذا الأمر من دون أن نخسر عقولنا.
المصدر
(وفق اتفاقية خاصة بين مؤسسة معنى الثقافية، ومجلة إيون).
تُرجمت هذه المقالة بدعم من مبادرة «ترجم»، إحدى مبادرات هيئة الأدب والنشر والترجمة.
الآراء والأفكار الواردة في المقالة تمثّل وِجهة نَظر المؤلف فقط.
 كن جزء من مجتمع مرّرها اشترك بنشرتنا.
كن جزء من مجتمع مرّرها اشترك بنشرتنا.