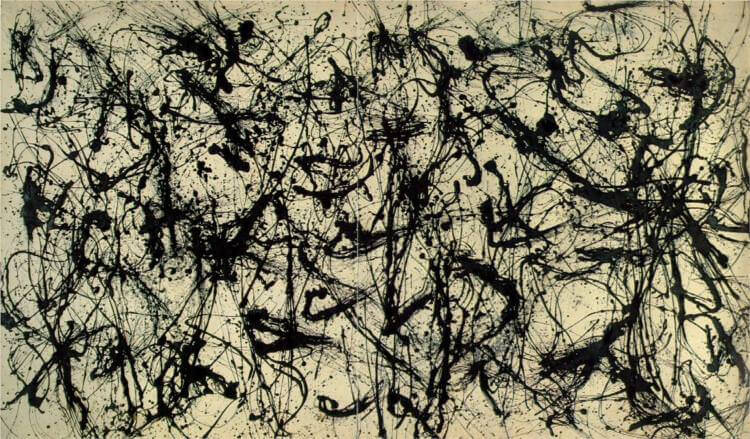
تحرير ومراجعة: بلقيس الأنصاري
المعلومات الصحيحة لا تصاحبها دائمًا هَالَة ساطعة تعلن صحتها. ما الذي يجعل شيئًا ما يستحق الاعتقاد؟
لا يمكنك أن تكون مخطئًا عن قصد. لرؤية هذا، جرّب إحدى حيلي الفلسفية المفضلة: اعتقد شيئًا تظن أنه خاطئ، مثلًا أن الشمس مجرد مصباح كبير. لا تتخيل أنك تعتقد أنها كذلك، بل اعتقد أنها كذلك فعلًا. وكن واثقًا من ذلك لدرجة أنك قد تراهن بقدر معتبر من المال على صحة هذا الاعتقاد. عندما أحاول هذا، أشعر بعائق إدراكي عجيب، كما لو أن هناك نفورًا فِطريًا من اعتقاد ذلك الأمر، خاصة أيّ شيء أظن بالفعل أنه خطأ. لسوء الحظ، هذا لا يعني أنه من السهل اعتقاد الحقائق فقط. فإذا كانت سهولة التعلّم والتفكير بقدر سهولة اتخاذ قرار بعدم السماح لأيّ شيء إلا الحقائق بالدخول؛ فلن نرتكب أخطاء أبدًا. لكننا نَزِل ونقع في أخطاء في كل وقت. يمكننا جميعًا التفكير في الأوقات التي اقتنعنا فيها بشيء تبيّن أنه خطأ، ولدينا جميعًا أوهامنا الإدراكية المُفضلة، وصورنا وتصوراتنا الملتبسة للمشاهد المستحيلة، وكل هذا يجعلنا على دراية بأن الأشياء ليست دائمًا كما تبدو.
مع هذا السجل الحافل، من المعقول التأمل في سبب انحراف تفكيرنا أحيانًا، ولماذا يستقيم في بعض الأحيان. تبدأ الإبستمولوجيا، أيّ الدراسة الفلسفية للمعرفة والاعتقاد والدليل، من هنا، من قابلتنا للخطأ. ومن هذه البداية، هناك العديد من المسارات تسلكها الإبستمولوجيا، وأنواع عديدة من الأسئلة تتعلق بتحديد هذه المسارات.
على سبيل المثال، يمكننا الاستمرار بالسؤال عن طبيعة التفكير نفسه. وهل التفكير لا يتجاوز مجرد تكوين اعتقادات وتحسينها؟ أم هو شيء آخر تمامًا؟ الخيَار الآخر هو أن نسأل عمَّا يعتبر “نجاح” أو “صواب” في الاعتقاد. يتعلق هذا المسار الثاني بما يسميه الإبستمولوجيون “التبرير”. إذن نظرًا لكون الأفكار الصحيحة لا يصاحبها توهج خاص يعلن عن صحتها، فإنه لا يمكننا استخدام الصدق كمؤشر لاعتقادات جيدة التكوين وذات قيمة. بدلًا من لك، قد نبحث عن شيء آخر من أجل فرز الاعتقادات والآراء الجيدة من الاعتقادات والآراء السيئة – شيء يبرر بعض الاعتقادات دون أخرى، ويفسّر مصداقية بعض الاعتقادات دون أخرى.
في الواقع، ما سبق يمثّل السؤال العظيم لدى العديد من الإبستمولوجيين: ما هو التبرير وما هي المصداقية credibility حقًا. ولكن، على طول الطريق، يضيق المسار، ويظهر سؤال جديد متعلق بالدور الذي يؤديه التبرير في اكتشاف الأشياء. بينما لا يمكن لمصفاة “الحقائق فقط” أن تحلّ مشكلة تجنب الأكاذيب والوصول للحقائق، هل يجب أن تقوم مصداقية فكرة ما بجعل نفسها واضحة لك على نحو غير ممكن للحقيقة؟ أم يكفي أن يكون رأيك ذا مصداقية، وفقط؟ تؤدي هذه الأسئلة إلى الجدل الشرس المسمَّى بجدل الداخلانية/الخارجانية في الإبستمولوجيا، لكن لا تدع أسماء المذاهب هذه تخيفك. كما سنرى، تؤدي الأسئلة الأكاديمية المتعلقة بالتبرير إلى أسئلةٍ أعمق بكثير حول موضوع الإبستمولوجيا نفسها.
لفهم ماهية التبرير، فكّر في التشبيه التالي. أمتلك خوذة مصغرة لكرة القدم الأمريكية عليها توقيع الظهير الربعي بريت فافر Brett Favre في السنة الأولى التي قاد فيها فريقه “Green Bay Packers” إلى مباراة البطولة “Super Bowl “، وأصبح أفضل لاعب في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (في الواقع، قد سلمته بنفسي الخوذة كي يوقع عليها). إذا كنتُ أرغب في بيع هذا التذكار الرياضي لك، فمن المفهوم أنك تريد التأكد من أن التوقيع ليس مزورًا، نظرًا لأن الخوذات الصغيرة، والأقلام ذات العلامة التجارية شاربي Sharpie، وصور بريت فافر ليس من الصعب الحصول عليها، ولا يمكنك كشف الزائف من الحقيقي بنفسك (التوقيعات الأصلية لا تأتي بتوهج خاص أيضًا).
ومن ثم فإن شهادة الأصالة certificate of authenticity الآتية من مقيِّم خبير، أيّ شخص يمكنه فحص التوقيع وتحديد ما إذا كان، في رأيه، بخط فافر نفسه، قد يضفي مصداقية على الادعاء القائل إن فافر قد وقّع على الخوذة. وبمجرد أن يصادق المقيِّم على شرعية التوقيع، يمكنك أن تطمئن وتشتري الخوذة على نحو مبرَّر. بل يمكننا أن نخطو خطوة إلى الأمام ونقول إنه إذا اشترى شخص ما الخوذة دون شهادة، فإن قراره متهور (قد نتساءل عمَّا إذا كان إنفاق المال على التذكارات الرياضية قرارًا متهورًا في المقام الأول، ولكن سيتعين علينا وضع هذه المشاغل جانبًا). عندما نتتبع شيئًا مهمًا، غالبًا ما نعتمد على شيء آخر لإرشادنا إلى وجوده أو غيابه – شيء مثل شهادة الأصالة – وتنطبق نفس الفكرة عندما يتعلق الأمر باعتقاداتنا، وأفكارنا، وآرائنا.
إن عيش حياة بشرية يعني السباحة في محيط من المعلومات تغذيه جميع القنوات: حواسنا، وذكرياتنا، وشبكاتنا الاجتماعية. ولكن، مثلما أن خربشات اليد على خوذة كرة قدم بلاستيكية لا تعلن عن نفسها كتوقيع حقيقي للعين غير الخبيرة، فإن المعلومات لا يصاحبها دائمًا هَالة ساطعة للحقيقة. ومن ثم فما يجعل شيئًا ما يستحق اعتقاده – ما يجعل الاعتقاد ذا مصداقية أو مبررًا – يجب أن يكون شيئًا آخر. لكن إذا كانت الاعتقادات تتطلب “ِشهادة الأصالة”، فما هي ماهية هذه الشهادات؟ أيّ، كيف يعمل التبرير؟ تخيل أنك مهتم بشراء الخوذة. إذا فحصها أحد الخبراء وأصدر شهادة أصالة حقيقية، واشتريتها، فأنت تشتري توقيعًا أصليًا مصدَّقًا عليه. ولكن كي تشتري بمسؤولية، أيّ كي يكون الشراء مبرَّرًا، كيف يجب أن تندرج شهادة الأصالة هذه في قرارك؟
بمجرد صدور الشهادة، فإن كل الأمور جاهزة لتشتري بمسؤولية.
هنا نحن أمام مدرسة من المدارس الفكرية: لا يمكنك شراء الخوذة على نحو مسؤول ما لم تكن على دراية بشهادة الأصالة أوّلًا. هذا يثير مجموعة من الأسئلة. كيف أكون على دراية، وما الذي أدري به؟ ومن يصادق على المصادقين؟ أليست الشهادات عرضة للتزوير مثل التوقيعات؟ كل هذه المشاغل هي مشاغل منصفة، ولكن يبدو أن الجاذبية الأساسية لهذه الفكرة واضحة بما فيه الكفاية. إذا لم تتمكن من فرز الخربشات الزائفة من خربشات فافر، فمن الطبيعي أن تريد وكيلًا يمكنه التقييم نيابة عنك. في النهاية، ألم نرغب في الحصول على علامة أوضح للمصداقية على وجه التحديد لأن أصالة التوقيع لم تكن واضحة لنا؟ ما الهدف من الشهادة إذا لم نتمكن من رفعها ونقول: «بهذه الشهادة عرفنا أن التوقيع أصلي»؟
إليكم مدرسة فكرية بديلة: ليس عليك أن تكون على دراية بالشهادة على الإطلاق حتى يجاز لك شراء الخوذة. فعلى الرغم من أنه يمكنك إلقاء نظرة خاطفة على الشهادة حتى تقوم بوظيفتها، إلا أنه لا يتوجب عليك ذلك. إذ تُعتبر الشهادة بمثابة سجل لحقيقة أن الخبير وجد التوقيع أصليًا، وطالما يوجد هذا السجل لما يجده الحَكَم الموثوق، يمكنك شراء الخوذة دون قلق. فبمجرد أن تحدث المصادقة، فإن كل الأمور جاهزة لتشتري بمسؤولية. أليست هي وظيفة الخبير في النهاية؟
تختلف هاتان المدرستان الفكريتان في كيفية إدراج شهادات الأصالة في قرارك. ونظرًا لأن المدرسة الأولى تقترح أن الشهادات يجب أن تكون داخلية لمنظورك كمشتري، يمكننا وصفها بأنها “داخلانية”. وحيث أن المدرسة الثانية تقول إن الشهادات يجب أن تُنتَج بالطريقة المناسبة للعمل التجاري، لا يتعين على المشتري مراجعتها أو فحصها.
يشبه هذا التمييز بين هاتين المدرستين الجدل الفعل بين الإبستمولوجيين حول طبيعة المبرِّر. هناك السؤال الأوسع المتعلق بما يبرر اعتقاداتنا، وهناك سؤال أضيق يتعلق بكيفية اندراج المبرر في حياة الشخص المفكر والمحقِّق. بالنسبة للداخلانيين في الإبستمولوجيا، لا يمكن تبرير اعتقادي ما لم يكن بمقدوري بطريقة ما أن أقيّم مبرره. أما الخارجانيون فينكرون ذلك؛ فهم يقولون إنه يمكنني امتلاك اعتقاد مبرَّر حتى لو لم أتمكن التحقق مما يجعله ذا مصداقية.
هل هذا جدل أكاديمي؟ بالتأكيد، لكن لا أعتقد أنه مجرد جدل أكاديمي. صحيح أنه من غير المحتمل أن تتعلم المزيد عن الداخلانية والخارجانية إلا إذا كنتَ تتلقى مساقات فلسفية عالية المستوى، لكن ما يتوفر لدى أي مهتم هو مفاهيم متنافسة عن أنفسنا كعارفين ومحققين، وبحث المفهوم الذي سيكون له الأسبقية في نظرية المعرفة. عندما نسأل الأسئلة الصعبة حول ملكاتنا الفكرية المعرضة للخطأ، من أين يجب أن نبدأ؟ ما هو تصورنا التأسيسي؟
لقد سلّم معظم الفلاسفة، لفترة طويلة جدًا، بالداخلانية باعتبارها تمثل الحس السليم. فإذا كنتَ تعرف شيئًا ما، أو لديك سبب وجيه لاعتقاده، فيمكنك أن تبرره لنفسك بأسباب يمكنك الاستشهاد بها. خذ سقراط كمثال. إن أسلوبه هو طرح أسئلة محددة على الخبراء المحليين حتى يصبح من الواضح أن الخبراء لم يعرفوا في الحقيقة ما الذي يتحدثون عنه. على سبيل المثال، في حوار “يوثيفرو” لأفلاطون، التقى سقراط بالكاهن المحلي والخبير بالآلهة، يوثيفرو نفسه، الذي يخطط لفعل شيء غير مقدَّس وفقًا للمعايير المحلية – وهو أن يوجه اتهامات ضد والده. يسأل سقراط كيف يمكنه، كرجل خبير بالآلهة، أن يقوم بشيء من الواضح أن الآلهة تدينه؟
يجيب يوثيفرو بأن خطته تتجاوز في الواقع معايير الآلهة. وهذا الجواب بالنسبة لسقراط لا يثير سوى المزيد من الأسئلة، الذي يضغط على يوثيفرو ويطلب منه أن يوضح ما يعنيه بالقداسة. إذا كانت خطة يوثيفرو مقدسة جدًا، أليس من المؤكد أنه يمكنه توضيح أسبابه وتوضيح طبيعة القداسة؟ ومع ذلك، تحت وطأة الاستجواب، يوقع نفسه في مأزق، فهو غير قادر على تقديم وصف واضح للقداسة. ينتهي الحوار عند هذا الحد، باعتذار من اللاهوتي الرئيسي في أثينا مفاده: «لقد تأخرت بالفعل على شيء ما».
لقد بجَّل الأثينيون يوثيفرو لكونه خبيرًا في الآلهة، لكنه لم يتمكن من الإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بمجال خبرته. تبدو “معرفته” ناقصة إلى أبعد حد. عندما ننظر إلى سقراط، نجد عنده الفكرة التي مفادها أنه إذا كنتَ تعرف شيئًا حقًا فيجب أن تكون قادرًا على تقديم وصف. فكما هو الحال في فصل الرياضيات المدرسي، يجب أن تكون قادرًا على إظهار عملك. من الناحية النظرية، يجب أن يكون وصفك هو شهادة المصداقية التي يمكن أن تبرر الاعتقاد، وهذا يجب أن يرضي الداخلانيين، لأنك أنتجت وصفك من أفكارك “من الداخل”. وهذا يجعله مناسبًا أيضًا للإجابة على أنواع التحديات التي قد يثيرها سقراط.
بينما تبدو التوصيفات السقراطية مناسبة في بعض المجالات (على سبيل المثال في الهندسة، حيث الإثباتات الصريحة خطوة بخطوة)، فإننا لا نتوقعها أو نطلبها دائمًا في مجالات أخرى. لا يستطيع العديد من المولعين بالمعلومات العامة إخبارك كيف يعرفون كل إجابة يقدمونها – إنها تنبثق في رؤوسهم فقط. تبدو ردودهم أفضل من التخمينات المحظوظة، لكنهم يقصرون كثيرًا عن النموذج السقراطي لتقديم السبب.
ما فائدة شهادة الأصالة التي لا يمكن إظهارها؟
ينطبق الأمر نفسه على مصادر التبرير الشائعة الأخرى، مثل شهادة testimony أُناس آخرين أو حواسّنا. ومع ذلك، يبدو أن هذه المصادر ترضي الفكرة الداخلانية الأساسية القائلة إن التبرير يجب أن يكون داخل خبرتنا. تقول إحدى وجهات النظر أن امتلاك خبرات من نوع معين يمنح اعتقادك نوعًا أضعف من التبرير، لكنه تبرير حقيقي بدرجة كافية. لنفترض أن لدي خبرة حسية: يبدو أنني أسمع صوت النقر الذي تحدثه أظافر كلبي على الأرض عندما يمشي. تقودني هذه الخبرة إلى اعتقاد أن كلبي يسير ورائي. هنا الخبرة السمعية تبرر اعتقادي. وهي لا تثبت أن كلبي على مقربة مني (بل ربما لا يكون حاضرًا)، لكنها تكفي لوضعي في موقف واضح أعتقد فيه أن كلبي على مقربة مني. تجسد وجهة النظر هذه، مثلها مثل وجهة النظر السقراطية، الفكرة الداخلاية من خلال وضع كل ما تحتاج للتبرير داخل منظورك، أيّ شيء ممكن لاستدلالك يكون متاحًا. لدي اعتقاد مبرر حول مكان كلبي لأنني مررتُ بخبرة تذكّرني بأصوات قدميه. والخبرات نفسها لا تحتاج إلى تبرير، لأنها، كما قال الفيلسوف رودريك تشيشولم Roderick Chisholm، في عام 1966، تعرض نفسها بنفسها self-presenting. فهي تجعل نفسها معروفة. وكيف لا يمكنها ذلك؟ إذن ما الذي يمكن أن يكون أكثر إشراقًا وظهورًا من الخبرة الواعية؟
حسنًا، الآراء تختلف. عبَّر ويلفريد سيلارز Wilfrid Sellars عن صعوبة دائمة تواجه فكرة العرض الذاتي: الخبرة الخام ليست مناسبة للتبرير. إنها ببساطة الأداة الخاطئة لهذه الوظيفة. إذا كان يوثيفرو قد أجاب على استجواب سقراط بتقليد شديد الدقة لخُطّاف المخازن barn swallow [طائر]، فربما أثار هذا التقليد إعجاب الفيلسوف، لكنه سيعتقد عن حق أن سؤاله لم يتلق النوع الصحيح من الرد على الإطلاق، وليس فقط أن سؤاله لم يُرَدّ عليه ردًا كافيًا. وبالمثل، إذا سألتني: “ما السبب الذي يجعلك تعتقد أن كلبك على مقربة منك؟”، ما فائدة الإشارة إلى أحداثي الداخلية غير المتكررة التي لا يمكن التعبير عنها؟ ما فائدة شهادة الأصالة التي لا يمكن إظهارها؟ لم أتمكن حتى من الاستشهاد بخبرتي أمام نفسي، لأنه بمجرد أن أمتلك الخبرة تختفي.
تقول كل وجهة نظر داخلانية، حتى تنوعاتها الأضعف، إن المبرر يجب أن يكون قابلًا للوصول من منظورك. فالمبرر يأتي دائمًا من الداخل. لكن ما هي قابلية الوصول؟ عادة ما تُصوَّر على أنها شيء يمكن أن يمتلكه المرء وهو جالس على أريكته، يتأمل أفكاره، لذلك إذا كان لديك ما يبرر اعتقاد أيّ شيء، يمكنك العثور على هذا المبرر هنا والآن من خلال النظر في الداخل. يصبح التأمل الوسيلة الوحيدة تبرير اعتقاداتك، وهذا يضع عبئًا كبيرًا على كاهل التأمل.
وهذا يعني أيضًا أن أي شخص لا يتأمل بالدرجة الكافية لا يمكن أن يكون لديه اعتقادات مبررة. كثيرًا ما نتحدث عمَّا يعرفه الأطفال الصغار جدًا، حتى قبل أن يتعلّموا الكلام، ونقول إن رفقائنا من المخلوقات تعرف الأشياء أيضًا. فقد أخبرك عن الفيبي الشرقي eastern phoebe [طائر] يعرف ويتذكّر مكان عشّه، لكن لا يمكن أن أخبرك بأن أحد أفراخه هو شحرور البقر [طائر]. في حين أن بعض الفلاسفة يقصّون هذه الأمثلة باعتبارها مجازية، فإن آخرين يجدون أشكالًا من الاستمرارية بين البشر البالغين الناضجين والحيوانات الأخرى – سواء كانت بشرية أو غير ذلك – لا يمكن تجاهلها. في النهاية كلنا نواجه نفس المشكلة الأساسية. وعلينا جميعًا أن نشق طريقنا عبر بيئة متغيرة لا تتعاون معنا.
إذن، لفهم وضعنا الإبستيمولوجي قد نبحث عن بديل للداخلانية. تركز الداخلانية على التأمل النظري الذي يجعل التبرير فكرانيًا intellectualise. قد يبدو هذا وكأنه شكوى مضحكة. إنه يعيد إلى الأذهان ما قاله – حسب ما يُروى – الفيلسوف سيدني مورجنبيسير Sidney Morgenbesser للسلوكي بورهوس فريدريك سكينر B. F. Skinner: «هل تخبرني أن من الخطأ أنسنة anthropomorphise الناس؟». ويزيد التناقض عندما نتذكر بعض الأمثلة التي تبدو إشكالية من وجهة النظر الداخلانية. تجسد الداخلانية الدقة الصارمة للفلسفة والعلم، حيث يكون البرهان والحِجاج هما العمود الركين في هذا النطاق، لكن عندما نبدأ في أخذ مصداقية اعتقادات الأطفال والحيوانات غير البشرية على محمل الجد نجدها تقصر عن هذه الدقة. فعادة هذه المخلوقات لا تتأمل، أو لا يمكنها أن تتأمل، ومن ثمّ ستجعلنا الداخلانية ننكر أن لديهم اعتقادات مبررة. يقول الخارجاني: “هذا هو خلل الداخلانية”.
برزت الخارجانية في الإبستمولوجيا باعتبارها مذهب الموثوقية reliabilism، الذي ينصّ على أن الاعتقادات تكون مبررة عندما تُنتَج من خلال عملية موثوقة. إن جاذبية هذا الرأي لا تخفى. فكما أشرنا بالفعل، نحن نعتمد على مجموعة متنوعة من قنوات المعلومات – الإدراك الحسي، الذاكرة، إلخ – ونعتمد على تلك القنوات تحديدًا لأنها تأتي بالإجابة الصحيحة في كثير من الأحيان. وبالتأكيد تعتمد عليها أحيانًا ونرتكب أخطاء (ذات مرة تأخرتُ ساعة ونصف على ندوة للخريجين معتقدًا أنني وصلتُ مبكرًا)، لكن العمليات نفسها تنجح في أوقات كثيرة بما فيه الكفاية، بحيث أنه حتى عندما تمدك باعتقاد زائف فإن هذا الاعتقاد لا يزال مبررًا. إن العملية المعرفانية الموثوقة تشبه خبير الأرصاد الجويَّة. إذ يمكنك أن تقبل منه كلماته حرفيًا حتى عندما يكون لديه بعض الأخطاء في سجله الحافل.
وكحال خبير الأرصاد الجويَّة، لا يجب أن تكون التشغيلات الداخلية للعملية المعرفانية الموثوقة شفافة لك من أجل أن تحقق ما يُتوقع منها. إذ يمكنك تكوين اعتقادات مبررة بناءً على ما تراه دون أن تدري أي شيء عن كيفية عمل الإبصار، أو حتى عن الموثوقية العامة لنظامك البصري. حسب مذهب الموثوقية، فإن المبرر ينبع من موثوقية العملية، وليس من إمكانية وصول الوعي إليها. ومن ثم فإن مذهب الموثوقية هو نظرية خارجانية، لا داخلانية.
بدون عبء إمكانية الوصول، يمكن للخارجانية أن تفسر مصداقية المفكرين غير المتأملين، مثل الطيور، والكلاب، والأطفال الصغار. قارَن فرانك رامزي Frank Ramsey ذات مرة بين الاعتقادات والخرائط، لذلك إذا قمنا بنمذجة التفكير على أنه إنتاج لخرائط داخلية وإبحار بها، فمن المعقول أن نرحب في مجموعتنا برفقائنا من المخلوقات. يحتاج كل شيء يفكر إلى إيجاد طريقه عبر البيئات التي يمكن أن تتغير فيها مواقع الطعام، والأصدقاء، والأعداء. لذلك عندما نفكر في المصداقية والتبرير لاعتقادات تلك المخلوقات، فإننا مهتمون بما يتطلبه نجاح تلك المخلوقات. فهي بحاجة إلى حواس تجعلها على اتصال بالعالم. وبحاجة إلى عمليات موثوقية للاعتماد عليها.
قد يشتكي داخلاني فيقول: “لكن ماذا عن الممارسة السقراطية المتمثلة في تقديم الأسباب وطلبها؟”، ويجيب القائلون بمذهب الموثوقية – وأنواع أخرى من الخارجانيين، في هذا الصدد – ببساطة بالتأمل العقلاني الخارجاني. تأتي اعتقاداتي حول اعتقاداتي من عملية موثوقة أخرى: الاستبطان. إن قدرة الإنسان الناضج على التسويغ العقلاني مدهشة ومناسبة تمامًا للمخلوقات الاجتماعية التي يتعين عليها التوفيق بين الأولويات التنافسية والأنا. لكن هذا ليس سببًا لاتباع الداخلاني في دعمها باعتبارها مصدر التبرير، أو باعتبارها وسيلتنا الوحيدة للتبرير.
ماذا لو كنت أحلم أو عالقًا في مصفوفة؟
تسبب حجة داخلانية أخرى في مزيد من المتاعب للخارجارنيين. دعنا نعود إلى قصة التوقيع. في نسخة من نسخ القصة، أنت تقرر شراء الخوذة على أساس شهادة الأصالة، وكل شيء يسير على ما يرام، وتكون فخورًا في النهاية بامتلاك توقيع حقيقي لفافر. لكن تخيل نسخة أخرى تحمل نهاية غير سعيدة: كان التوقيع مزورًا في الحقيقة بدقة شديدة لدرجة أن المقيِّم أصدر شهادة أصالة له، وبناءً على هذه الشهادة، اشتريتَ الخوذة. في القصة الأولى، تستخدم الشهادة لاتخاذ قرار، وتحصل على ما تريد. وفي النسخة التعيسة، يمكنك استخدام الشهادة لاتخاذ قرار، تمامًا كالنسخة السعيدة، لكن تسوء الأمور بلا أي خطأ من جانبك.
يقول الداخلانيون إنه على الرغم من النهايات المختلفة للقصة، يمكننا أن نرى خيطًا مشتركًا يمر عبر كلا النسختين من القصة. ففي كلتا الحالتين، أنت فكرت وقررت على نفس الأسس. وحسب ما هو ظاهر لك، كل شيء هو نفسه “من الداخل” في كلا النسختين. فحقيقة أن التوقيع قد زُوِّر في النهاية التعيسة لا تحدث فرقًا في مسؤولية شرائك، حيث أنك استندت في قرارك على مصدر ذي مصداقية. إذا اتخذتَ القرار الصحيح في الحالة السعيدة، فإنك اتخذت القرار الصحيح في الحالة التعيسة.
يمكننا الحصول على نفس النتيجة مع الاعتقاد. فكر في حالة الطقس عندك وأنت تقرأ هذه السطور. كيف هو؟ بالنسبة لي، الجوّ رطب جدًا ومتلبد بالغيوم. لنفترض أنني على حق؛ وهذه هي الحالة الجيدة. ولكن في الحالة السيئة، على الرغم من أن كل شيء يبدو تمامًا كما هو في الحالة الجيدة (أي أن الجو يبدو رطبًا وغائمًا)، فأنا في الواقع أحلم، أو عالق في محاكاة دون علمي، أو أُخدَع بطريقة أخرى، ولذا فإن اعتقاداتي عن كل شيء تقريبًا، بما في ذلك الطقس، خاطئة.
مثل النهاية السعيدة والتعيسة لقصة التوقيع، فإن نتائج اعتقادي – الصدق في الحالة الجيدة والخطأ في الحالة السيئة – لا تبدو ذات صلة حقًا بما إذا كنتُ قد شكلت اعتقادي بالطريقة الصحيحة. فكل ما يجب أن أبقيه في الحالة الجيدة موجود في الحالة السيئة، والعكس صحيح. من الواضح أن النتائج الخارجية لاعتقاداتي مختلفة، لكن ليس المبرر.
كافح الخارجانيون من أجل تفسير لماذا تبدو اعتقاداتي في الحالة الجيدة والحالة السيئة على قدم المساواة. يمكن للقائل بمذهب الموثوقية أن يشير إلى موثوقية حواسي لتفسير مبرري في الحالة الجيدة، لكن ماذا عن الحالة التي أحلم فيها أو أكون عالقًا في مصفوفة؟ إن عمليات تكوين اعتقادي لن تكون موثوقة في الحالات السيئة، لذلك لن يكون لدي فيها اعتقادات مبررة. وهذا يتعارض مع الانطباع الذي يأتينا عند النظر في تلك القصص. يمكنك اتخاذ القرار الصحيح وتخسر، حتى في حالات الخداع المستمر.
بدا الأمر وكأننا بدأنا بسؤال بسيط: أيًّا ما كان التبرير، هل هو داخلي أم خارجي؟ وقد رأينا أن الأمر ليس بهذه السهولة. فعلى الرغم من أن هذا يبدو وكأنه نزاع حول ادعاء واحد، إلا أنه في الحقيقة صدام بين برامج بحثية مختلفة. وفقًا لأحد طرفي النزاع، عندما نتحدث عن تبرير اعتقاد ما، فإننا نتحدث عن اعتقاد كائن تأملي مستقل، شخص يمكننا محاسبته، شخص مسؤول أمام الآخرين. وبإمكان المعتقدين (ويجب عليهم) تفسير أنفسهم بالأسباب الوجيهة.
لكن الطرف الآخر لا يخالف فقط في هذه النقطة الأخيرة. وإنما يخالف في الصورة الكلية للمعرفانية كتفسير تأملي. فالتفكير ليس للتنظير بالتحديد، ولكن هو للعمل والعيش. ووفقًا للقائلين بذلك، علينا أن نجعل دور المعرفانية في الحياة الحيوانية مركزيًا في فهمنا للمصداقية. أما تقديم الأسباب وطلبها فيأتي لاحقًا، وهو مشتق من الاهتمامات الأساسية للمخلوقات ذات اللحم والدم.
العارفون والمعتقدون يتفاعلون مع عالَم مجهز مسبقًا من خلال تكوين آراء بحجم الجُملة.
هذه رؤى غير متوافقة لماهية العارفين. عندما نؤطر الأسئلة المتعلقة بقابليتنا للخطأ كعارفين، علينا أن نسأل: “قابلية الخطأ في ماذا تحديدًا؟”. لكن جدل الداخلانية/الخارجانية، كما يحدث عادة، يبدأ من النهاية، كما لو كان لدينا بالفعل وصف مُرضٍ لماهية ما نقوم به عندما نتحقق: “هل يجب أن نفترض هذا؟”.
فكّر في مشكلة الذهن-الجسد بعد رينيه ديكارت. قد يقول المادي ردًّا على استنتاج ديكارت أن الذهن شيء غير مادي: “لا، الذهن هو الدماغ! إنه شيء مادي”. لكن تمهل – فـ بالمماهاة بين الذهن والمادة، نكون قد أيدنا عن غير قصد فكرة ديكارتية مركزية: تنتمي الأذهان إلى الفئة العامة للأشياء أو المواد stuff. ومع ذلك، قد لا يكون الذهن كذلك على الإطلاق. فإذا تناولنا “مشكلة الذهن-الجسد” على أنها اختيار بين الجواهر غير المادية والجواهر المادية، فقد نفقد بديلًا ثالثًا، وهو أن “الذهن” قد يكون أشبه بمجموعة من القدرات بدلًا من أن يكون موضوعًا. قد يكون نوعًا من النشاط وليس جزءًا آخر من الجسد.
وبنفس الطريقة، قد يخفي جدل الداخلانية/الخارجانية قضايا أعمق وبدائل واعدة. ليس الأمر أن سؤال “هل التبرير داخلي؟” سؤال خاطئ أو مشوّه، وإنما هو يحد من خياراتنا عند نقطة يجب أن تكون فيها المساحة المنطقية للإمكانات مفتوحة على مصراعيها. ففي الأخير، ما هي ماهية العارف، وفقًا للداخلانيين والخارجانيين؟ العارفون والمعتقدون يتفاعلون مع عالم مجهز مسبقًا من خلال تكوين آراء بحجم الجُملة. لكن هذا الادعاء ليس معطى، وليس أكثر من فكرة أن الذهن هو مادة.
دعونا نستذكر خطواتنا. لقد تعلّمنا شيئًا من التساؤل عن المبرر وعن ما إذا كان داخليًا. فقد رأينا كيف يمكن للمفاهيم المختلفة للمبرر أن تجسد نظريات مختلفة عن ماهية العارفين. ولدينا فرصة لاتخاذ المسار الذي ذكرناه في البداية، لاستشكاف سؤال أكثر أساسية. بالتأمل في سجلاتنا الحافلة، نجاحاتنا وإخفاقاتنا، يمكننا أن نسأل: “ما هو التحقيق؟ وما الذي نقوم به عندما نحاول أن نعرف؟”.
الهوامش
نيت شيف Nate Sheffis: كاتب وأستاذ مساعد بجامعة كونيتيكت Connecticut.
المصدر
(وفق اتفاقية خاصة بين مؤسسة معنى الثقافية، ومجلة إيون).
تُرجمت هذه المقالة بدعم من مبادرة «ترجم»، إحدى مبادرات هيئة الأدب والنشر والترجمة.
الآراء والأفكار الواردة في المقالة تمثّل وِجهة نَظر المؤلف فقط.
 كن جزء من مجتمع مرّرها اشترك بنشرتنا.
كن جزء من مجتمع مرّرها اشترك بنشرتنا.